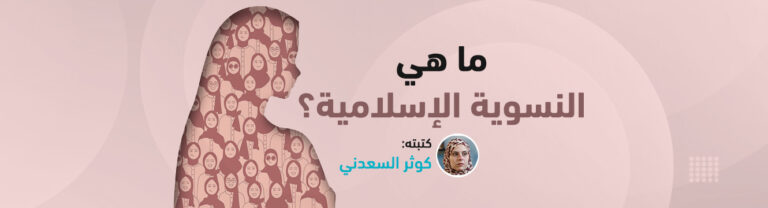عندما يُطرح مصطلح ” النسوية الإسلامية” في أي نقاش غالبا ما يقابل بالرفض أيا كانت انتماءات المتعرضين له، وفي هذا المقال سنتعرض بإيجاز لمفهوم النسوية الإسلامية ومراحل نشأته.
بدأت إرهاصات “النسوية” في العالم العربي مبكرا قبل أن تُرصد كتيار واضح المعالم من خلال كتابات نسائية متفرقة منذ نهاية القرن التاسع عشر مثل قواميس تراجم النساء، والتي بدأتاه مريم النحاس بـ “معرض الحسناء في تراجم مشاهير النساء” عام 1879 وزينب فيواز بـ “الدر المنثور في طبقات الخدور” عام 1894 وقدمت هذه القواميس نماذج نسائية يُحتذى بها في فترة كان التركيز فيها على الأدوار النسائية شيء غير مسبوق ([1]).
بينما اهتمت عائشة التيمورية بقضية تعليم النساء، ففي كتابها “نتائج الأحوال في الأقوال والأفعال” الصادر عام 1887 م كتبت عن إحساسها بالحزن لعزلتها في “كهف الحريم” ووجهت مشاركة مشاعرها إلى “أخواتها” من النساء اللواتي عانين الشعور نفسه فأنشأت بذلك نوع من الأخوية والترابط المشترك بين النساء المعزولات.
وكتبت أيضا في “الأدب” عام 1889 “يا رجال بلادنا، يا أيها الذين يتحكمون في شؤوننا، لماذا تركتم النساء متخلفات بلا سبب؟” ([2]).
وأنشأت هند نوفل ابنة كاتبة السير مريم النحاس جريدة “الفتاة” لتفتتح بها الصحافة النسائية وأكدت من خلالها أن مبدئها الوحيد هو الدفاع عن المحرومات لتعبر عن آرائهن وتدافع عن حقوقهن، ورغم كونها أكدت أن الكاتبات لن يتخطين قواعد الأخلاق أو يرتكبن ما يعده المجتمع الخطيئة الكبرى “الزنا” لمجرد كونهن كاتبات وأن المحتوى يلتزم بالمعايير الأخلاقية، إلا أن مجرد وجود جريدة نسائية هو أمر راديكالي آنذاك ([3]).
وشهدت بدايات القرن العشرين أيضا كتابات نسائية متفرقة بنت على ما سبقها وكانت بمثابة امتداد لها مثل كتابات ملك حفني ناصف وزينب الغزالي وعائشة عبد الرحمن ونظيرة زين الدين ([4])، واعُتبرت النساء الناشطات الأمهات الأوائل للنسويات التاليات، وظهر مصطلح “النسائية” عام 1923م واستخدمته المصريات لتعريف كتاباتهن وتعريف منظمتهن “الاتحاد النسائي المصري”، أما مصطلح “النسوية” فقد ظهر قبل ذلك في فرنسا عام 1880م ولكنه اشتهر وتوسع استخدامه لاحقا بعد استخدامه في إنجلترا في تسعينيات القرن التاسع عشر، وانتشر المصطلح في الولايات المتحدة في أوائل القرن العشرين ([5]).
وتُدرج كتابات النساء العربيات أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين ضمن الكتابات “النسوية” رغم عدم نشأة المصطلع وذيوع استخدامه إلا بعد ذلك بسبب آرائهن وأفكارهن وبرامجهن وأعمالهن وليس لأنهن صنفن أنفسهن كنسويات.
أما مصطلح “النسوية الإسلامية” فاكتسب شهرته مع تأسيس الجمهورية الإسلامية في إيران عام 1979 حيث بدأت بعض الناشطات بحركة إصلاح تشريعي طالبن فيها بأن ينتجن من خلال الفكر الشيعي حقوقا للمرأة ويطالبن بها، ومن هنا ذاع صيت مصطلح “النسويات الإسلاميات”، ومن ثم أسهمت بعضهن في صدور مجلة “زنان” عام 1992 كشهلا شركت وزيبا مير حسيني ([6]).
بينما اشتهر مصطلح “النسوية الإسلامية” في العالم الإسلامي السني العربي على يد مجموعة من الباحثات المتخصصات من خلال الدراسة والكتابة عن وضع المرأة المتدني في المجتمعات الإسلامية والعربية وعلاقة هذا بالنص المقدس في تسعينيات القرن الماضي من خلال تفكيك المعارف التاريخية البشرية عن النصوص الإسلامية التأسيسية.
تشترك صاحبات الفكر النسوي الإسلامي مع أصحاب الأيدولوجيات النسوية الأخرى في نقد المجتمع القائم والتصور الخاص بالمجتمع المثالي لكنهن تختلفن معهم في استراتيجية الانتقال من المجتمع القائم للمثالي، نظرا لأنهن وإن كن ينطلقن من أن المعارف الدينية جزء من المشكلة، لكنهن ترين أن الحل في العودة إلى النص المقدس واستنباط معارف دينية جديدة حوله.
تميز أصحاب الفكر النسوي الإسلامي بتركيزهم على تحقيق مفهوم (العدالة) كقيمة عليا مرجعية في الإسلام يمكن على ضوئها إعادة قراءة المصادر الأصلية لإنتاج معرفة دينية منصفة للنوعين.
وفي عام 2006 عقدت لجنة الإسلام والعلمانية باليونسكو مؤتمرا للنقاش حول ما هي النسوية الإسلامية وهل هناك نسوية إسلامية ([7]).
فكانت نقطة الإنطلاق المشتركة لدى الباحثات المشاركات هي المرجعية الإسلامية من خلال منهج تأويلي للنصوص الدينية المتعلقة بالنساء، من خلال العودة للقرآن مباشرة لتقديم تفسيرات ومعارف جديدة تبين خطأ القراءة التقليدية “الذكورية”، وتثبت أحقية النساء في انتاج معارف دينية وعدم استبعادهن.
وساهمت خلفيات الباحثات المختلفة من تخصص في المناهج والآليات اللسانية، والتاريخ، والتحليل الأدبي، وعلم الاجتماع، والأنثروبولجيا، في تعزيز منهج التأويل لديهن.
وتقول عالمة الاجتماع الإيرانية زيبا مير حسيني: “بالكشف عن تاريخ خفي، وبإعادة قراءة الأصول الدينية، يتم التدليل على أن التفاوتات (أشكال عدم المساواة) الشاخصة في الشريعة الإسلامية ليست مظاهر للإرادة الإلهية، إنما هي تركيبات إنسانية” ([8]).
تثير هذه المنهجية تحفظ كثير من المسلمين بالطبع خاصة مع استخدام كثير من الباحثات لمصطلحات إشكالية عند رفضهم للتفسيرات السابقة: كالاستبداد، والذكورية، والأبوية، وعدم المساواة، وتدرك الباحثات المشتغلات في منهج النسوية الإسلامية ذلك، لكنهن يؤكدن أنهن يرجعن إلى إيمانهن الأساس بالنص القرآني المقدس المساواتي ولا ينطلقن من منهج “النسوية الغربية” ([9])، الذي يقصي الدين كمرجعية.
ومن أبرز الحركات النسوية التي اعتنت بإنتاج المعرفة الدينية من منظور إيماني “حركة مساواة” ([10]) التي أُسست عام 2009 في ماليزيا، للعمل على نشر السردية التي تعكس قيم العدالة في الإسلام بهدف كسر هيمنة الفكر المحافظ على الخطاب الديني وتوضيح إمكانية إصلاح قوانين الأسرة والممارسات التمييزية في المجتمعات المسلمة المتنوعة، وكذلك إتاحة المعرفة المتعلقة بمفاهيم النوع الاجتماعي (الجندر) في الإسلام، وإنتاج معارف أوسع وصياغة مفاهيم وسرديات جديدة حول اتجاهات إصلاح قوانين الأسرة.
وتعرف أميمة أبو بكر النسوية الإسلامية بأنها إعادة قراءة الثقافة الإسلامية بكل مكوناتها من منظور نسوي، يزيل الكثير من الأوهام التي أطرت دونية المرأة دون أن يكون الواقع الفعلي مطابقا للتمثلات التي أنتجتها.
أما أماني صالح فتقول إن “النسوية الإسلامية” هي ذلك الجهد الفكري والأكاديمي والحركي الذي يسعى إلى تمكين المرأة انطلاقا من المرجعيات الإسلامية، وباستخدام المعايير والمفاهيم والمنهجيات الفكرية والحركية المستمدة من تلك المرجعيات وتوظيفها إلى جانب غيرها([11]).
وتعرفه الباحثة اللبنانية حُسن عبود: “جهد علمي تقوم به مجموعة من النساء المسلمات في العالم العربي لقراءة النصوص الدينية من القرآن والحديث، وربط الأحكام الفقهية الجزئية بالمبادئ الإسلامية الكلية ثم نقد التراث المتحيز ضد المرأة وحقوقها الإنسانية بهدف تغيير أنماط الفكر الذكوري التقليدي وتجديد الفكر الإسلامي” ([12]).
ويرى بعض الإسلاميين أن الفكر النسوي في جوهره استعماري وأن النسوية الدينية تغليف للخطاب النسوي بالدين، لتغيير أفكار وسلوك المرأة العربية ([13]).
ولا يقتصر هذا النظر على الذكور، بل ترى كثير من الإسلاميات أن النسويات الدينيات علمانيات، وترفضن النسوية، ويعتقدن ضرورة تطبيق حقوق النساء من خلال تطبيق الشرع الإسلامي كاملا، لأنه يحتوي على الحق الشامل، وترين أن “النسوية” و”الإسلام” مصطلحان متناقضان، فالنسوية تنطلق من أيدولوجيا المساواة التامة، مفترضة وجود صراع بين الإناث الذكور، في حين أن الإسلام لا ينطلق من حتمية الصراع بين النوعين، ولا تمييز نوع على نوع ([14]).
يظهر تباين المواقف حول النسوية الإسلامية إشكالية المصطلح، واختلاف الأطراف حوله في الحقول المعرفية المتباينة كالحقل المعرفي الإسلامي وحقل العلوم الإنسانية الذي تنتمي له “النسوية”، وهذا الاختلاف في التعريف ليس شكليا، فكل منتج من منتجات النسوية الإسلامية يعكس فهمه للشريعة ومصادرها ومنهجه التأويلي، وبالتالي فالتعامل مع ما تقدمه “النسوية الإسلامية” من معرفة بأحكام كلية من قبول أو رفض ليس الخيار الأمثل للباحثين عن المعرفة، إنما يكون التعامل انتقائيا بحسب ما ينتج من معرفة بالحكم الجزئي عليها.
[1] مارجو بدران، رائدات الحركة النسوية المصرية والإسلام والوطن، صـ 34، المجلس الأعلى للثقافة، 2000.
[2] المرجع السابق، صـ 35.
[3] المرجع السابق، صـ 37.
[4] أميمة أبو بكر، النسوية والدراسات الدينية، صـ 20، مؤسسة المرأة والذاكرة، 2012.
[5] مارجو بدران، رائدات الحركة النسوية المصرية والإسلام والوطن، صـ 42، المجلس الأعلى للثقافة، 2000.
[6] ميسون ضيف الله موسى الديوني، النسوية الإسلامية في العالم العربي المعاصر والمرجعية الإسلامية. المجلة الأردنية في الدراسات الإسلامية، صـ 7، ع3، 2018.
[7] فهمي جدعان، خارج السرب.. بحث في النسوية الإسلامية الرافضة وإغراءات الحرية، صـ30، الشبكة العربية للأبحاث والنشر، ط1، بيروت، 2010.
[8] المرجع السابق، صــ 37.
[9] المرجع السابق نفسه، صــ 60/ 61.
[11] آسيا شكيرب، النسوية الإسلامية والموقف من الحديث النبوي رفعت حسن وألفة يوسف نموذجا، مقاربة تحليلية نقدية، مخبر الدراسات العقدية ومقارنة الأديان، جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية، الجزائر.
[12] ميسون ضيف الله موسى الديوني، النسوية الإسلامية في العالم العربي المعاصر والمرجعية الإسلامية. المجلة الأردنية في الدراسات الإسلامية، مج 14, ع3، 2018.
[13] خالد قطب وآخرون، الحركة النسوية الدينية وخلخلة المجتمعات العربية المجتمع المصري أنموذجا، ص166، دار الكتب المصرية، ط1، 2006.
[14] عبد الحليم عطية أحمد، النسوية الإسلامية: قراءة في النقد ونقد النقد، مجلة الاستغراب، صـ 106، س 4, ع 16، 2019.