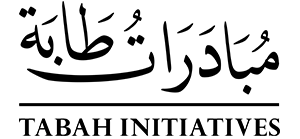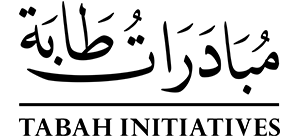الإجابة:
الأصل أن كل باحثٍ عن الحقيقة يجب أن يخطّ إليها منهجًا علميًا، لا يشوبه الهوى أو الوهم، وأن يلتزم هذا المنهج لا ينحرف عنه، تلك حقيقة واضحة لا ينبغي أن يتماري فيها أحد من الناس. من هنا كانت الحاجة إلى وضع مناهج للبحث العلمي ووضع معايير وضوابط حاكمة لهذا النشاط الإنساني، تأتي في مقدمتها الدقة والموضوعية والأمانة العلمية والتجرد واحترام الرواية ونقد النصوص داخليًا وخارجيًا، هذا بصفة عامة في كل العلوم، مع الأخذ في الاعتبار خصوصية كل علم، وبالتالى خصوصية منهجه. لكن في عصرنا الحالي تغيرت النظرة إلى مفهوم العلم ودوره ودائرته، لا سيما بعد الثورة العلمية في الغرب، فغلب على ظن كثير من العلماء أن هنالك منهجًا واحدًا هو منهج العلم الطبيعي؛ ذلك لأن الفكر المادي الذي هيمن على عصر الحداثة وما بعدها لا يرى مصدرًا للحقائق الموضوعية إلا الطبيعة، وعليه فلا منهج يوصل إلى الحقائق إلا منهجها، فنشأ عن ذلك نظريات ورؤى قاصرة معرفيًا لا تستوفي مصادر المعرفة ولا وسائلها ثم تدًعى أنها علمًا وتحاول فرض نفسها على أنها حقائق مسلمة غير قابلة للنقاش. فالمذهب المادي يرى أن حقيقة الوجود هي المادة، كما أنها هي منبع المعارف والوعي والعقل، والعلم الطبيعي او علم الطبيعيات لا يمثل بالنسبة لأصحاب هذا الفكر سوى حفرة يتخندقون بداخلها، فإن واجهتهم مشكلات فلسفية فسوف يمّنون انفسهم إن العلم الطبيعي سيحلها ولو بعد حين، يتضح ذلك من خلال انتظارهم ل”نظرية كل شئ” أي نظرية واحدة يفسرون بها أو من خلالها جميع ظواهر الكون، هربًا من الحاجة إلى إله أو أي تفسير غيبي. لقد أخطأ هؤلاء عندما ظنوا أن المادة هي الحقيقة القصوى، إذ العلم الطبيعي نفسه يقوم على مفاهيم غير مادية، مثل مفهوم اللامتناهي في الرياضيات. وحتى لو سلمنا أن العلم يعنى بالحقائق الموضوعية، وأن الدين يعنى بالقيم الروحية، فإن طلب العلم في ذاته مبني على قيمة روحية هي حب الحق، فطالب العلم طالب حقيقة. إذا نظرنا إلى هذا الأصل الذي يقوم عليه فكرهم سنجده مبنيًا على أساس خاطئ وقاعدة غير مستقيمة؛ ذلك لأن دعواهم بأن العلم الطبيعي كافٍ للإنسان في تفسير كل الحقائق وتقديم الحل لكل المشاكل الحياتية دعوى تحتاج إلى دليل، وعند إقامتهم لهذ الدليل، إما أن يعتمدوا على العلم التجريبي نفسه، وهم بذلك يستدلون على صحة الشئ بالشئ نفسه، وهو دور باطل. وإما أن يستدلوا على صحة دعواهم بغيره، وهم بذلك قد خالفوا مقولتهم “لا يوجد طريق للمعرفة إلا العلم التجريبي نفسه”.
يأتي هنا سؤال مهم: هل عملية الحكم تشترط المعرفة التامة والإحاطة الكلية بحقيقة الموضوع وكنهه، أم يكفي أن تتوافر معرفة لبعض جهاته ووجوهه بحيث تكون هذه المعرفة مصححة لعملية الحكم عليه؟
الجواب: أن الإنسان المنصف لا يوقف الحكم على أي موضوع على أن يتم تصور الموضوع تصورًا تامًا من جميع الوجوه، فأكثر الأحكام تكون على موضوعات غير مدركة إدراكًا تامًا، ولكن تكون مدركة من وجهٍ ما، إما وجه ذاتي أو غير ذاتي، ثم يقوم الباحث بالحكم عليه نفيًا أو إثباتًا مع ذكر المسوغ لحمل هذا الحكم على الموضوع. إذن دعوى أن الحكم والكلام في الإلهيات تتوقف على التصور التام، والتصور التام المحيط بحقيقة الإله غير حاصل بالفعل، ولذلك فيستحيل الحكم عليه إيجابًا أو سلبًا، هي في الحقيقة مجرد مغالطة، فنحن نحكم بوجود الذرات والمجال الكهرومغناطيسي والأفلاك وغير ذلك، ولا يوجد في أغلب هذه الموضوعات تصور تام لها، بل غايته أن يحصل علم بها من بعض الوجوه، ومن ثم يتم الحمل والحكم. وهذا أمرٌ واضح لا ينبغي التوقف عنده ولا العناد فيه.
إن العلم لما أثبت أن للكون بداية، وبالتالى فهو مخلوق، مما يعني أن إلهًا خلقه، لكن فلاسفة الإلحاد رفضوا التسليم بذلك، وعادوا للتمسك بمبدئهم المعروف بمبدأ التثبت؛ ومضمونه: ما لا نستطيع أن نرصده بحواسنا، فهو غير موجود[1].
ونحن نقول: إنه من المسلمات أن الحواس لا تصلح مقياسًا وحَكَمًا مطلقًا على كل الموجودات؛ لأنها نسبية ومحدودة، بحكم أن الإنسان نفسه كائن مخلوق محدود القدرات والإمكانات، ولا يمكنه تجاوزها. وحتى لو سلمنا بقدرة الحواس فلا يصح إطلاق هذا الحكم، إلا إذا قام الإنسان برصد وفحص كل ظواهر ومظاهر الكون عن طريق استقراء تام، وتأكد أنه لا يوجد في الكون سوى ما رآه أو أدركه بحواسه، وهذا محال. “أضف إلى ذلك وجود كائنات لم يكن الناس يعرفونها، لكن العلم اكتشفها، وتأكد لدينا أنها كانت موجودة، كالذرة والجاذبية والبكتريا والفيروسات. وحسب زعم تلك المقولة الإلحادية فإن تلك الكائنات لم يكن لها وجود قبل أن يكتشفها الإنسان”[2]. قبل ذلك كله، إذا دققنا في مبدأ التثبت الذي يتبناه الملحدون فسنجد فيه نقضًا للاستدلال العقلي؛ إذ هم قد قصروا معرفتهم على المعرفة الحسية فقط دون المعرفة العقلية.
ومع أن عمدة العلم الطبيعي الحديث هو المنهج التجريبي الاستقرائي[3]، إلا أن هذا لا يعني وجود اتفاق على طبيعة هذا المنهج، إذ لا بد أن نجد اختلافًا حول كل قضية من قضاياه “، وهكذا نلاحظ أنه بالرغم من أن مئات الكتب قد تم تحريرها ونشرها عن المنهج العلمي، وكان من المفترض أن يكون هناك اتفاق بوجه عام حول طبيعة النشاط المنهجي، إلا أن هذا الاتفاق ظل بعيدًا عن أن يتحقق”[4]. اضف الى ذلك ان العلم التجريبي لا يقين فيه انما يقوم على مبدأ الاحتمال، فالحقائق العلمية ليست حقائق مطلقة، ولا أدلّ على ذلك من تحول العلماء من نظرية إلى أخرى، بل هي حقائق صحيحة ونسبية في حدود دقة وتطور الأجهزة المستخدمة. “إن تغيّر النظريات العلمية لا يعني أن الكون حقائقه متغيرة بقدر ما يعني أن الزاوية التي نري بها الواقع قد تغيرت”[5]. فالحقيقة العلمية ليست هي الواقع وإنما ما يقرره العلماء عن هذا الواقع. لا بد أيضًا من معرفة طبيعة النظريات العلمية؛ وأنها ليست نصوصًا مقدسة، بل هي عبارة عن أفضل التفسيرات للظواهر الطبيعية، وقد تأتي نظرية لاحقة تكمل هذه النظرية وتسد ثغراتها وهذا ما يشكل المعرفة التراكمية. وقد يحدث أيضًا أن تأتي نظرية أخرى بمنظور مختلف تمامًا فتحدث قطيعة معرفية مع ما سبق من نظريات علمية أخرى فيما يعرف بتغيير البراديم. إنه من المفارقات التي لا تخلو من إفراط، أن الذين يلحدون كثيرًا ما يخلعون على إلحادهم رداء العقلانية[6]. وما يفعلون هذا إلا لظنٍ منهم بقدرة “العقل العلمي” على الكشف عن أعمق حقائق الكون والتعبير عنها، في محاولة منهم أن يجمعوا بين الإلحاد الفلسفي والإلحاد العلمي[7]؛ لكي يظهروا بمظهر الجدية الفكرية والعلمية، وأيضًا محاولة منهم لإقناع غيرهم بأن لديهم القدرة الكافية على التنظير. هذا الخلط بين المنهجين هو عين ما يعتمد عليه الملحدون الجدد أو ما يُعرف بتيار الإلحاد الجديد[8]. لكن ونحن في طريقنا للبحث عن الحقيقة، لا بد أن نميّز بين نوعين من المعرفة: معرفة العلم ومعرفة الهداية الدينية، “فمعرفة العلم مستقلة عن شخص العالِم، قد يأخذها من غيره وقد يحملها إلى غيره، وقد يتساوى فيها الآخذ والمانح. أما معرفة الهداية الدينية فهي جزء من حقيقة الإنسان لا تنفصل عنه، ولا تخلو من مقوماته الشخصية، فلا تكفي فيها المعلومات والبراهين، ولا تغني هذه المعلومات والبراهين عن معونة من بديهة الإنسان. إذ أن هذه البديهة جزء من الحقيقة التي يتم بها الإيمان، وليست الحقيقة كلها خارجية يتلقاها الإنسان كاملة من غيره، سواء كان ذلك الغير إنسانًا حياً أو مظهرًا من مظاهر الطبيعة”[9]. إن نقص البراهين أو الأدلة العقلية التي يستدل بها المؤمنون على وجود الله – إن سلمنا بذلك – سببه أن “البرهان قوة ترغم العقل على التصديق، ولا يأتي الإيمان بإرغام بل بطلب وشوق واجتهاد في التحصيل، فإن لم تشعر النفس بمكان الإيمان منها فلا محل للبرهان فيها. وإن شعرت بهذا المكان فالبرهان متمم لشئ موجود يعاونه ويعضده”[10]. لقد وضع الله في نفس كل واحدٍ منا دليلًا على وجوده: “وفي أنفسكم أفلا تبصرون”، يكفينا من أنفسنا في هذا المقام مثال الروح التى هي سر الحياة، نؤمن بوجودها فينا، وان كنا لا نستطيع إدراكها حسيًا، إذا كان هذا حال الروح المخلوقة فما بالنا بالخالق سبحانه؟!.
إن الاستدلال على وجود الله رغم دليل الفطرة إنما هو من باب تعدد الأدلة وتعاضدها لتزداد المعرفة ويقوى اليقين، قال تعالى: ” قد بيّنا الآيات لقوم يوقنون” البقرة:118، لننتبه إلى أن الآيات هنا جاءت بصيغة الجمع ومعناها الأدلة، هذا من رحمة الله وعدله، إذ لم يجعل الدليل على وجوده دليلًا واحدًا أو من نوعٍ واحد؛ لأن الناس متفاوتون؛ كلٌ بحسب إدراكه واختياره. هذا الاختلاف الذي هو دليل الاختيار سنة من سنن الله في خلقه، قال تعالى: “ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولايزالون مختلفين” هود:118. إذا كان ذلك كذلك فلا عجب إذن أن نجد علماء الكلام أو العقيدة يجعلون المبحث الأول في كتبهم ” أول واجب على المكلف هو النظر المؤدي الى معرفة الله عزوجل”، إذ معرفة الله هي أصل الاعتقادات وغاية الغايات، فمن أجلها كان خلق المخلوقات، والنظر المقصود هنا كما يقول الإمام سيف الدين الآمدي في أبكاره، هو عبارة عن “تصرف العقل في الأمور السابقة المناسبة للمطلوبات بتأليفٍ وترتيبٍ؛ لتحصيل ما ليس حاصلًا في العقل”، أي إعمال الفكر في المقدمات الموجودة والمسلّمة لدينا، وترتيبها على نحوٍ معين، ليتوصل من خلالها الى نتيجة معينة. فالمعاني السابقة المناسبة للمطلوب؛ كالمادة للدليل، والتأليف الخاص كالصورة؛ وهو -أي الدليل- مركب منهما أي من المادة والصورة، ولا يصح إلا بصحتهما، وفساده قد يكون بفسادهما، أو بفساد أحدهما. هذه المواد التي يتركب منها الدليل (مقدماته) منها ما هو قطعي ومنها ما هو ظني. والمقدمات القطعية منها البدهيات؛ وهي الأمور التي يصدقها العقل من غير توقف على نظر واستدلال، كالعلم بأن الواحد أقل من اثنين. ومنها المشاهدات وهي كل قضية صدق العقل بها بواسطة الحس، كعلمنا بحرارة النار. كذلك منها المجرّبات وهي كل قضية يصدق العقل بها بواسطة الحس مع التكرار ونوع من النظر، كالعلم بأن دواء كذا مفيد لعلاج كذا….الخ.
من أجل هذا كان تعريفنا للعلم أوسع، ومن ثم كانت نظرتنا أشمل وأعمق من تلك النظرة السطحية التي تقف عند حد مشاهدة المخلوقات، إن المؤمن بنفاذ بصيرته يرى الخالق من خلال خلقه ويدرك المنعم من خلال نعمه التى لا تعد ولا تحصى. إنه يستشعر اسم الله “الباطن” الذي احتجب عن خلقه ابتلاء لهم وامتحانًا لإيمانهم، وإن كان ظاهرًا بالأدلة والآيات لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد.
لقد أعلن العلماء الماديون أنه لا دليل علمي على وجود الله، ونحن نقول لهم: إن العلم التجريبي المعتمد لديكم غير قادر على التعامل مع هذا السؤال أصلا، سواء من ناحية الإثبات أو من ناحية النفي. سؤال وجود الله مجاله الدين والفلسفة وليس العلم الذي يقوم على الملاحظة والتجربة ولا يخرج عن حدود المادة. الغريب أن هؤلاء يطالبوننا دائما بالموضوعية والتزام المناهج العلمية المنضبطة وهم أبعد الناس عنها. يدّعون أن العلم الطبيعي يقف على الحياد من أمور العقيدة، ثم يقومون بتوظيف النظريات العلمية لخدمة مذهبهم الإلحادي الذي باتوا يبشّرون به ويروّجون له ليل نهار. ليس هدفي هنا هو التشكيك في قيمة العلم التجريبي وأهميته، بل ما أريد التأكيد عليه هو تحديد دوره ووظيفته، بحيث لا يطغي على باقي العلوم والمعارف الإنسانية. إن من يطالبنا بدليل علمي تجريبي على وجود الله سبحانه وتعالى لكي يؤمن به، إنما يرهن إيمانه بتوفر التفسير الكامل لظرفه الوجودى أو لسر الحياة ككل، إنه يطلب من الخالق أن يسلّم أولًا لمطالبه، وأن يمنحه جميع أسراره، كشرط للإيمان. بينما العلم الحقيقي واليقيني يأتي فقط من تسليم الإنسان بالخالق وله في آن واحد. والواقع أن المعرفة، أية معرفة، غير ممكنه بغير التسليم للشئ الذي يُراد معرفته. فطالب المعرفة يهب عقله للموضوع المراد معرفته، قبل أن يهبه ذلك الموضوع شيئا من أسرار طبيعته. إنهم يفعلون ذلك حتى مع الحيوانات والحشرات التي يضطرون لمراقبتها في بيئاتها ويسايرونها في عاداتها، ليجمعوا حقائق حياتها. ثم يأتون ويطالبون الخالق العظيم بأن يخضع لهم ولتجاربهم حتى يقروا له بحقه عليهم وقدره بالنظر إلى قدرهم! هذا لعمري عجز مريع في تصور المطلوب! فإن تصور المطلوب جزء لا يتجزأ من انكشاف حقيقته، إذ معرفة الشئ فرعٌ عن تصوره. وهؤلاء يريدون أن يخضع الإله لشروطهم ولمنطق حججهم الاستلالية أولا، دون التزام منهم بشئ! مع العلم بأنهم هم المخلوق وهو الخالق!
إن هؤلاء لا يستطيعون بناء أطروحة كاملة عن الكون والحياة، هم فقط يحاولون نقض ما يقدّمه الدين من أطروحات، تتوافق في حقيقتها مع العقل والفطرة الإنسانية ” فطرة الله التى فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله”. إنهم يحاولون أن يستبدلوا الإله تارة بالعلم وأخرى بالطبيعة هربًا من الإيمان والتسليم بالأمور الغيبية، ومن تحمّل تبعات هذا الإيمان وتوابع ذلك التسليم. إن الإلحاد سيظل حالة فارغة معطلة من أي دلالة حقيقية وموضوعية مالم يكن هناك ما يمكن الإلحاد به. لقد بذلوا ما بوسعهم بغية تفنيد كل قضية تمت بصلة إلى الله عز وجل وإلى عالم الغيب، غير أنهم في الحقيقة لا يمتلكون صلاحية القيام بذلك، غاية ما في الأمر هو اقتصار مذهبهم وأدلتهم المادية على عالم المحسوسات، وحسب التعبير المنطقي فحدود استنتاجاتهم محصورة في إطار القضية الموجبة الجزئية؛ لذا ليست لديهم الصلاحية ولا القابلية العلمية على نقض كل قضية لا تخضع للحس والتجربة.
ونختم بحقيقة يثبتها الفيلسوف الألماني روبرت سبينان إذ يقول: “إن الإلحاد الجديد لا يضعنا في خيار بين الإله والعلم كما يدّعي، بل بين الايمان بالإله وبين التخلى عن قدرتنا العقلية على فهم الكون. فببساطة إذا لم يكن هناك إله (كمصدر عاقل حكيم لعقولنا الحكيمة) فلن يكون هناك أساس منطقي للثقة بعقولنا، ومن ثم لا ثقة في العلم، بل لا ثقة في الحقيقة. بذلك يفقد العلم والحقيقة مصداقيتهما وضمانتهما”[11]. لذلك يظل وجود الله هو التفسير الأبسط والأنسب لكل الشواهد العلمية على ملكات الإنسان العقلية.
[1] رحلة عقل، ص81.
[2]نقد العقل الملحد، ص 10.
[3]المنهج الاستقرائي: هو منهج يقوم على الاستقراء الذي يعرف بأنه تتبع الأمور الجزئية للوصول إلى حكم كلي يشملها، هذا الحكم الكلي يمكن صياغته في قانون عام. وقد عرف المنهج الاستقرائي تطورات نقلته من صيغته التقليدية التي وضعها فرنسيس بيكون (1561- 1626)، وديفيد هيوم (1711- 1776) إلى صيغته المعاصرة المستعملة في العلوم الفيزيائية النظرية التي جعلته أقرب إلى المنهج الاستنباطي منه إلى الاستقرائي. تيبس، يوسف: منهج العلم، وهو بحث منشور في مجلة رؤى العدد الثلاثون، ص73.
[4]التفكير العلمي الأسس والمهارات: مجموعة مؤلفين، ص 75،76.
[5] العالم بين العلم والفلسفة، ص33.
[6]وإن كان في كثير من الأحيان يكون الدافع إلى الإلحاد عاملًا نفسيًا، أوخللًا اجتماعًيا، أو بسبب اضطراب داخلي، نتيجة لوجود الشر والآلام والأمراض وغيرها، دون فهم الحكمة من وراء ذلك. قد يكون أيضًا من قبيل المكابرة والعناد والغرور، أو تحررًا من قيود التكاليف الشرعية وتمردًا عليها.
[8]تيار الإلحاد الجديد: ظهر هذا الاصطلاح في الغرب عام 2006م، حيث لم يكتف هذا التيار بما عليه الإلحاد المعاصر من إحياء للفلسفة الوضعية بما فيها من نظرة مادية، بل رفض التعايش مع الدين أو المتدينين. ولم يكتف بنقض الألوهية والمفاهيم الدينية، لكنه تبنى أسلوب الهجوم والسخرية. وقد قام هذا التيار العدائي على إثر كتابات ظهرت في الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا بين عامي 2004-2007م لمجموعة من الملحدين، على رأسهم ريتشارد دوكينز من خلال كتابه (وهم الإله)، وكذلك الفيلسوف دانيل دينيت في كتابه(كسر التعويذة، الدين كظاهرة طبيعية)، وطبيب الاعصاب سام هاريس وكتابه (نهاية الإيمان)، والإعلامي كريستوفر هيتشنز في كتابه (الإله ليس عظيمًا، كيف يسمم الدين كل شئ). وهم الإلحاد، ص 28-29