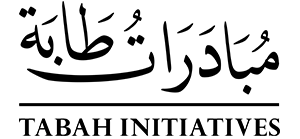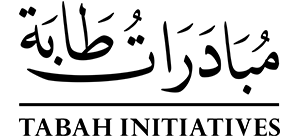عزة رمضان
كثيرًا ما نجد أنفسنا نربط بين الأسباب ونتائجها بشكل حتمي لا يقبل الشك؛ بمعنى أننا إذا فعلنا كذا فلابد أن تكون النتيجة كذا وكذا، ولا نتردد في هذا الربط بين الأسباب ومسبباتها إلا إذا كان الأمر الذي نحن بصدده من المستجدات التي لم يسبق لنا ممارستها أو تجربتها قبل كذلك، عندها ينخفض مستوى توقعاتنا حتى يكاد ينعدم الجزم والقطع بأحد الاحتمالات دون الآخر.
ترى ما الذي يجعلنا نحكم بيقين فيما جربناه واعتدنا عليه، بينما يتلاشى هذا اليقين والجزم فيما يستجد علينا من أمور فنقف أمامه نلاحظ ونراقب منتظرين تكرار هذا الأمر حتى يزداد اليقين درجة بدرجة مع كل تكرار؟
الحقيقة أن هذه المسألة لم تغب عن بال الإنسان وفكره منذ أن بدأ يفكر، ذلك لأنها ترتبط بأفعاله الكائنة وبمقدار تنبؤاته بما سيكون، في تعاطيه مع مكونات هذا العالم الذي يعيش فيه. إلا أنها لم تستمر على تلك الصورة البسيطة التي بدأت بها. بل أخذت في التعمق في عقول المفكرين والفلاسفة، وبدأ كلٌ في مناقشتها وتفسيرها ومعالجتها ضمن إطار فكري معين، حتى تشعبت المسألة وتزايدت الأسئلة من حولها، وأصبح الباحثون فيها – في الغالب – واقعين بين احتمالين لا ثالث لهما؛ إما تبسيطها بشدة ومعالجتها بطريقة سطحية ساذجة ،أو تعقيدها ومناقشتها بشكل فلسفي عميق لا يفهمه غير المتخصصين.
في هذه المقالة سأحاول أن أخرج عن هذين الاحتمالين السابقين؛ ذلك لأن مسألة السببية بالفعل لها ثقلها الفكري وعمقها الفلسفي ومردودها الديني والعقائدي، ومن ثم لا يمكن تسطيحها بشكل يكاد يقضي على الفكرة تمامًا أو على الأقل لا يوفيها حقها. سيتم طرح هذه المسألة من خلال مناقشة عدة اسئلة، من أهمها: هل معرفتنا بأن لكل حادث من الحوادث علة هي السبب في وجوده، تجعلنا نقول إن مبدأ السببية هو أحد المبادئ العقلية الأولية؟ وتصبح علاقة السببية حينئذٍ واحدة من الضرورات العقلية المنطقية؟ هل ما نشاهده من تعاقب الحوادث في الكون مطرد حتمي؟ أم هو قائم على الاحتمال والتجويز العقلي؟ وهل للمعارف الدينية كلمة في نظريات تفسير الحوادث الكونية؟
والسؤال الأهم: هل ثمة تعارض بين اعتقاد المسلمين بالقدرة الإلهية المطلقة وبين اعتقاد مبدأ السببية وتحققه في حوادث العالم؟
إذا كان لدينا بعض المسلمات العقلية التي تقضي بأن الشئ هو هو، ولا يمكن أن يكون إلا هو، وأن الشئ ونقيضه لا يجتمعان، فإنه يمكن أن ننطلق من هذه المسلمات إلى عالم المحسوسات ونقول: لا شك في أن هذا العالم له حقيقة وصفات في نفس الأمر، منها أنه حادث أي موجود بعد عدم، ووجوده هذا ليس بذاته ولا من ذاته، بل وجوده لابد أن يكون من غيره، وموجده لابد أن يكون وجوده واجبًا لا يقبل العدم أبدا.
إذ تقرر هذا فإنه باستطاعتنا إدراك أن هذا العالم ليس قائمًا بذاته، بل هو محتاج إلى خالقه ابتداءً واستمرارًا. هذا الخالق الذي أوجد العالم على هذا النحو من الحكمة والإبداع، هو أيضًا من أراد جعل هذا العالم يسير وفق قوانين ومبادئ خاضعة لقدرته تعالى، من أهمها قانون الأسباب. هذه الأسباب هي سنة الله التي أجراها وعادته في خلقه. أو إن شئت قلت: إنها تجلّى للفعل الإلهي. هذا القدر ليس عليه خلاف بين مفكري الإسلام؛ إذ الكل متفق على أن العالم وما فيه من موجودات، جميعها من خلق الله عزوجل. لكن منشأ النزاع كان في تحديد نوع العلاقة بين الموجودات وتأثير بعضها في بعض، باعتبار بعضها أسبابًا وبعضها مسببات. فإذا قلنا أن لكل حادث سبب؛ فهل لهذا السبب طبيعة ذاتية تأثيرية مستقلة يستطيع بها أن يؤثر في غيره من الموجودات؟
جاءت الإجابة عن هذا السؤال مختلفة؛ نظرًا لاختلاف المنطلق الفكري لدى كل مذهب، وما يعتمده في الاستدلال على أصوله الفكرية والعقدية. فالمعتزلة الذين يذهبون الى القول بالعلية الطبيعية، والتوليد، يلزمهم القول بالخصائص الذاتية للأشياء، وبناء عليه فإن الله -عندهم- يفعل بالأسباب، وإن كان سبحانه يقدر على العمل بغير سبب. فالمعتزلة إذًا يرون أن الأسباب وسائط بين القدرة الإلهية أو الإنسانية، والأفعال المتولدة عنهما. أما حقيقة التأثير فليس لهذه الوسائط فيما يتولد عنها؛ فهم يرون أن لها تأثيرًا، ولكن تأثيرها ليس من ذاتها، لكن بالقوة التي أودعها الله فيها. هذا وإن كان يؤكد الضرورة التي تحكم العالم إلا أنه لا يعني تجاهلهم للقدرة الإلهية، إذ الأمر كله مرجعه لله عزوجل.
أما الأشاعرة – وعلى رأسهم الإمام الغزالي – فقد أسسوا لنظرية العادة، من خلال التمييز بين أقسام خمسة من المعارف اليقينية وهي؛ الأوليات، والمشاهدات الباطنة، والمحسوسات الظاهرة، والمعلومات بالتواتر، وأخيرًا التجريبيات؛ والتي يُعبر عنها باطراد العادات، وذلك مثل حكمك بأن النار محرقة، والخبز مشبع، فالعقل هنا يحكم بواسطة الحس، وبتكرر الإحساس مرة بعد أخرى، إذ المرة الواحدة لا تحصِّل العلم. يقول الإمام الغزالى في كتابه محك النظر: “وإذا تأملت هذا الفن حق التأمل، عرفت أن العقل نال هذه بعد الإحساس والتكرر بواسطة قياسٍ خفي ارتسم فيه ولم يثبت بعد شعوره بذلك القياس؛ لأنه لم يلتفت إليه، وكأن العقل يقول: لو لم يكن هذا السبب يقتضيه..لما اطرد في الأكثر، ولو كان بالاتفاق لتخلف..وهذا الأمر يحرك أصلًا عظيمًا في معنى تلازم الأسباب والمسببات، والتعبير عنها باطراد العادات”.
ثم يتابع الإمام الغزالي نظريته في كتابه تهافت الفلاسفة قائلًا: “الاقتران بين ما يُعتقد في العادة سببًا وبين ما يعتقد مسببًا، ليس ضروريًا عندنا، بل كل شيئين، ليس هذا ذاك، ولا ذاك هذا..فليس من ضرورة وجود أحدهما وجود الآخر”، بل إن سبب هذا الاقتران مرجعه إلى قدرة الله عزوجل وتقديره، وأنه في مقدور الله عزوجل فك هذا الاقتران متى شاء. هنا لابد لنا أن نتساءل مع الغزالي عن الدليل على كون النار هي فاعل الإحراق؟ سنجد أنه لا دليل للقائلين بذلك سوى مشاهدة حصول الاحتراق حين ملاقاة القطن للنار، والمشاهدة تدل على الحصول “عندها لا بها”. الطبيعة إذًا لا تؤثر بذاتها، بل هي مسخرة، وقوانينها ليست حتمية؛ فحوادثها ترجع الى العادة. والقدرة الإلهية المطلقة هي التي تختار وضع معين لربط الممكنات بعضها ببعض. لهذا أنكر الاشاعرة “ضرورة” التلازم بين الاسباب والمسببات، وذلك من خلال إنكارهم للحتمية الطبيعية وأخذهم بمبدأ الجواز والإمكان، بل وجعلهم أخص وصف لله تعالى هو القدرة المطلقة، حتى صار الأصل الأصيل عندهم: “استناد جميع الممكنات إلى الله القادر المختار ابتداءً وبلا واسطة”.
إن اطراد النظام الكوني الواقعي المشهود لا ينفي -ولا ينبغي له أن ينفي -رحابة القدرة الإلهية. لقد عرض القرآن الكريم لكلا الأمرين في انسجام واتساق بديعين، فتأمل كيف يصور القرآن العلاقة بين الكواكب كما قدّرها بارئها الحكيم {لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ} [يس: 40] فأنت إذًا أمام التقدير الحاسم الذي أبرم أمره إبراما، وأنت إذًا أمام عالم الأمر الذي لا يملك سوى أن يصدع وأن ينصاع بداية ونهاية. هذا النظام المحكم البديع يُستثنى منه بعض الظواهر النادرة والتي تُعرف ب”المعجزات”، فخروجها عن النظام الذي أقامه الله في هذا الكون ليس عبثًا، بل هو من قبيل الحكمة الإلهية؛ إذ انها إيقاظ للعقل البشري من سباته المألوف، واستنقاذ له من الرتابة والاعتياد الذي يعمي الذاهل عن سبيل الرشاد.
يلزمنا أخيرًا – لفهم السببية كما يراها الأشاعرة – أن نميّز بين مستويين من النظر ونوعين من القطع. بالنسبة للنظر، هناك مستوى يتم التركيز فيه على السبب العادي الدنيوي بمعزل عن الأحكام العقلية التي تتعلق به، وعن بقية الأمور التي ترتبط به. لكن هناك مستوى آخر من النظر هو أعم وأشمل من ذلك؛ لأنه وإن كان يأخذ السبب العادي بعين الاعتبار، إلا أنه لايقف عند هذا الحد من النظر السطحي، بل يربط بين هذا السبب وبين خالق الكون وموجد الاسباب.
إذًا معنى كون هذه الأمور أسبابًا محصور في أن الله عزوجل ربط بينها وبين أمور أخرى بمحض إرادته وقدرته فقط، فظهر استمرار هذا الارتباط أمامنا بمظهر السببية والتأثير. ومن المعلوم أن طول الاقتران بين أمرين في الوجود والعدم قد يُخيل إلى الذهن ارتباطًا سببيًا بينهما، وإن لم تكن ثمة أي رابطة حتمية في واقع الأمر. وأنه من المستحيل أيضًا أن تكون هذه الأسباب مؤثرة بذاتها مع ما نعلمه فيها من صفة الحدوث بعد العدم.
وأما نوعي القطع فهما: قطع عقلي فيه جزم بالارتباط بين السبب والمسبب، مع امتناع تصور الانفكاك بينهما، ودون توقف على تجربة أو تكرار أو وضع واضع. وقطع آخر عادي يكون فيه الارتباط بين السبب والمسبب ارتباطًا عاديًا، يجوز عقلًا تخلفه، إلا أنه لا يتخلف بحسب اطراد العادات. هذا النوع الأخير وإن كان يفيد القطع واليقين إلا أن العقل يجوّز فيه وجود احتمال آخر لا يتصور امتناع حدوثه، وإن تيَّقن أنه لن يحدث في الواقع، وهو ما يعرف بالحكم العادي.
وختامًا نستطيع أن نقول إجمالًا: إن معظم الشبهات التى ترد على ألسنة غير المؤمنين ناتجة عن الخلط بين هذه المفاهيم الدقيقة، وبين درجاتها القريبة من بعضها البعض من جهة ، وبين ربطها بمبحث التصورات أم التصديقات من جهة أخرى. إنهم إن استطاعوا التمييز بين هذا كله انحلت لديهم الكثير من الإشكالات والشبهات. وقد أكدّ الإمام الغزالي على هذا المعني المهم في كتابه الاقتصاد في الاعتقاد، فقال: “عرفت قطعًا أن أكثر الأغاليط تنشأ من ضلالِ مَن طلبَ المعاني من الألفاظ، ولقد كان من حقه أن يقرر المعاني أولًا، ثم ينظر في الألفاظ ثانيا، ويعلم أنها اصطلاحات لا تتغير بها المعقولات، ولكن من حُرِم التوفيق.. استدبر الطريق وترك التحقيق”.