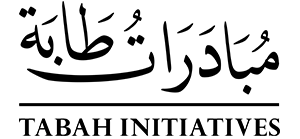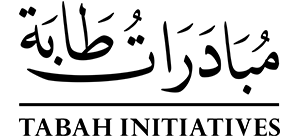د. جاد الله بسام
باحث في العلوم العقلية وتفسير القرآن
في عالم واسع جداً يموج بأصناف البشر وأديانهم ولغاتهم وتقاليدهم، وهو في الوقت نفسه بالغ التعقيد والدقة، كتعقيد دماغ الإنسان وأعصابه وأفكاره ورقة مشاعره وأحاسيسه، نرى الإنسان -تحت وطأة ضغط الحدث وسرعة الخبر-ينشطر إلى نصفين يفقد كل منهما صاحبه، فلا هو مع عقله ولا هو مع قلبه.
في ظلّ هذا العالم وضياع الإنسانية فيه، لا بدّ أن نحافظ على أغلى الأشياء وأهمّها، نعم، الدين أهمّ الأشياء، لأنه ليس مجرد رأي أو فكرة، إنّ الدين رأي تنبني عليها الآراء، وتنبثق عنه الأخلاق، وتؤسس عليه الأعمال والسلوكيات، وله وعلاقة وثيقة بنظرة الإنسان إلى نفسه وغيره والوجود من حوله، إنه الذي يربط الحياة بما بعدها، ويجعل لوجودك في هذه اللحظة بالذات قيمة عليا قد تفتديها بكل ما تملك، وبدون الدين قد تكون تلك الأشياء الثمينة =”لاشيء”.
ما الدّين الحقّ؟
قد لا يكونُ من الحكمة أنْ نخوض في هذا السّؤال الجوهريّ مفترضين الاتفاق على وجود معرفة دينية أصلاً، فضلاً عن ادّعاء حقّية دين بعينه، لكنْ لا يُنكِر أحدٌ أن الغالبية العظمى من سكان العالم متدينون ويعتقدون صحة دينهم وأحقيته، وينظرون إلى العالم وسكانه بعيون متدينة محافظة، وقد عالجنا شيئاً من هذا في مقال سابق (قبل أن تكون مسلماً).
ولا بديل للعاقل أنْ يترك التقليد الأعمى، وينظر في هذه القضية بعيون جريئة وقلب غزاليّ متعطّش إلى درك حقائق الأمور حين قال: “فتحرك باطني إلى طلب حقيقة الفطرة الأصلية، وحقيقة العقائد العارضة بتقليد الوالدين والأستاذين، والتمييز بين هذه التقليدات”، وهذا الأمر أرشدنا إليه النبي محمد صلى الله عليه وسلم حين قال: «كُلُّ إِنْسَانٍ تَلِدُهُ أُمُّهُ عَلَى الْفِطْرَةِ، وَأَبَوَاهُ بَعْدُ يُهَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ وَيُمَجِّسَانِهِ، فَإِنْ كَانَا مُسْلِمَيْنِ، فَمُسْلِمٌ» رواه مسلم، بل أرشدنا القرآن إليه في كثير من الآيات، وصار شعار القرآن في هذه المسائل مبدوءاً بـ “فاعلم…”، فغير العلم واليقين لا يكفي هنا.
الحقّ هو القول أو الاعتقاد الصحيح المطابق للواقع، فمثلاً قولك: كاتب هذه السطور كان حياً وهو يكتب، قولٌ حقّ، لأنه مطابق للواقع الذي يحكم بأنّ الميت لا تصدر عنه الكتابة وتحريك الأصابع، والاعتقاد بأنّ جدّ جدّ جدّك كان موجوداً في يوم ما اعتقاد صحيح، لأن ذلك لو كان خطأ ما كنت أنت موجوداً الآن.
والدّين -الذي هو مجموع الأحكام الدينية التي يعتنقها المتديّن ويدين بها-ينطبق عليه الأمر نفسه، فالدين الحقّ ليس أيّ عقيدة يعتنقها الإنسان، بل هي التي تكون صحيحة في نفسها فقط ومطابقة للواقع، لا تلك الأحكام التي تكون غير صحيحة، فلا بدّ إذن من معيار لاعتبار عقيدة ما صحيحة مطابقة للواقع أو لا.
إذن ما نسميه الواقع والحقيقة هو معيارنا في الحكم، وتقريباً للصورة في الأحكام الدينية؛ نضرب المثال الآتي: شخص يعتقد أنه لا يوجد حياة بعد الموت، وينكر البعث والنشور واليوم الآخر، هل هذا قول واعتقاد؟ نعم، هو اعتقاد وقول قطعاً. لكن هل هو صحيح؟ للإجابة على ذلك يجب أن نعرف ببساطة: هل سيكون يوم قيامة أو لا، فإن ثبت أنه سيكون يوم قيامة فالاعتقاد المذكور باطل، وإن ثبت أنه لن يكون يوم قيامة فالاعتقاد صحيح، وإن لم يثبت شيء لا نفياً ولا إثباتاً، فلا يمكن الحكم على هذا الاعتقاد فنتوقف فيه، كل هذا بديهي وواضح جداً.
المكوّنات الدّينية. ما طبيعتها وكيف نعرف حقّيتها؟
ينبغي لنا أن نتعرف على المكونات التي تشكل ما نسميه ديناً، حتى يتسنى الحكم عليها بأنها حقّ أو لا، وأنها تتعدّد أو لا.
إن الدّين في النماذج الدينية العالمية الكبرى ينقسم إلى قسمين: (عمليّ: عبادات ومعاملات، كالصلاة والبيع)، و(علميّ: اعتقادات وأخلاق)، وكل قسم منهما يُعرف الحقّ فيه بكيفية معينة، ولو أخذنا جزءاً من المكونات على حدة، فليست هي ذلك الدين، بل الدين مجموع المكونات كـ “كل واحد”.
أمّا القسم الأول كالصّلاة والبيع؛ فلا خلاف أنّ الأديان قد تختلف فيه، تبعاً لاختلاف إرادة الشارع، قال الله تعالى مخاطباً النبيّ صلى الله عليه وسلم: {وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً} [المائدة: 48]، فعند المسلمين: الكتاب والسنة والإجماع والتواتر العمليّ، وغير ذلك من الأدلّة هي التي تعرفنا بهذه الأحكام العملية، فالبيع الصحيح هو الذي توافرت فيه الشرائط الشرعية… وهكذا، وعند غير المسلمين يراجعون هذه الأشياء في مصادرهم الخاصة، إلا أنّ هنا قضية مهمّة جداً تعتبر أساساً لكل الأحكام التي تدخل في هذا القسم العملي، وهي مدى حجية تلك المصادر ومشروعيتها، وهل هي باقية أو منسوخة، فإنّ مشروعية هذه الأحكام ليست ذاتية، بل ترجع إلى إرادة الشارع الذي وضعها وأقرّها، ونضربُ مثالاً للتقريب: لو كان في قانون العمل أنّ الإجازة الرسمية يوم الجمعة، فهذا حكم مشروع بحسب القانون، أما إذا عُدِّل القانون وصارت الإجازة يوم السبت فلم يعد يوم الجمعة مشروعاً للإجازة، وهذه النقطة المهمة في نسخ الشرائع تنقلنا إلى القسم الثّاني من الأحكام الدينية، وتبين لنا أن الحقّ واحدٌ في هذا النوع من الأحكام العملية، لكن ليس لطبيعتها الذاتية، بل لوجود نسخ الشرائع.
والقسم العلميّ (العقائد والأخلاق) يتميز عن سابقه بأنه لا يتبدل ولا يتحوّل، ولا يقبل نسخاً أو تغييراً، فاعتقاد أصحاب الأديان الكبرى وجودَ الله تعالى اعتقادٌ صحيح، لأنّه مطابق للواقع، فإنّ الله موجود فعلاً، وكيفية معرفة ذلك راجعة إلى الأدلة العقلية المعتبرة، واختلاف الناس في مثل هذه العقائد لا ينفي وجود الحقّ، ولا يقتضي تعدّده، غاية ما هنالك أنّ العقلاء قد يخطئ بعضهم في إدراك الأدلة والتصديق بها، وتبقى الحجة في الأدلة لا في مجرد الآراء المختلفة.
وقد يبدو غريباً أنْ نجعلَ الأخلاق ضمن القسم العلميِّ في الأديان، خصوصاً أنّ ذلك خلاف المشهور عند كثيرٍ من الناس، لكن لو تأملنا في مفهوم الخلق وعرفناه فلن نستغرب ذلك أبداً، إنّ الخلق هو صفة ترسخ في النفس والعقل والقلب، وسبب رسوخها إدراك قوي ومعرفة بحقائق الأمور ومآلاتها، ثمّ هذه الإدراكات الأخلاقية تدفع الإنسان لفعل الخير وتمنعه من فعل الشرّ، فليست الأخلاق هي الأفعال نفسها، بل هي دوافعها وموانعها.
فمثلاً: خلق (العفّة) هو صفة للنفس ناشئة عن إدراك معنى الشهوة وموقعها وما تفضي إليه من المضارّ والمنافع، فالإنسان العفيف هو الذي يضبط شهوته وفق ميزان الصواب والخطأ، وأما الإنسان الشهوانيّ فلا يضبط شهوته لضعف إدراكه وقلة علمه وعدم انقياده لميزان الصواب والخطأ، وفهمُنا للأخلاق بهذه الصورة يجعلنا قادرين على تخلية أنفسنا عن الرذائل، وتحليتها بالفضائل بصورة علمية مدروسة، فلأجل هذا جعلنا الأخلاق ضمن القسم العلمي في الأديان، من حيث إنها إدراكات راسخة يمكن أن نستدل عليها ونقنع بها أطفالنا.
إذن؛ المكونات الدينية لا يمكن فصلها عن بعضها، وتتمثل في (عقائدَ) هي أساس للأخلاق والأعمال، وهي التي تحدّد كون الدين حقاً أو باطلاً، حتى الأديان التي ترى أنه لا ضرورة لوجود عقيدة ما، نجد أن هذه الدعوى هي في نفسها عقيدة، فلا مجال لخلوّ الدين عن “عقيدة”، ثمّ لا بدّ من تحديد كونها مطابقة للواقع أو لا، فبهذا نعرف الدين الحقّ.
هل يتعدّد الدّين الحقّ؟
تأسيساً على ما سبق؛ فالدين الحقّ هو الذي يشتمل على الأحكام المطابقة للواقع، لكن ألا يمكن أن تكون الأحكام المطابقة للواقع متعدّدة؟ هذا يرجع إلى طبيعة تلك الوقائع، هل تقبل التعدد أو لا؟
الوقائع الاعتقادية التي ترجع إليها المكونات الدينية أشبه بجملة خبرية، مكوّنة من مبتدأ وخبر، إما أن تكون صادقةً أو كاذبة، مثلاً: الله موجود، محمد وعيسى رسل الله، الإسلام حقّ، الدين الحق واحد، يوم القيامة كائن، النار موجودة، الإسلام ناسخ للأديان، فكل عقيدة من هذه العقائد -سواء اتفق فيها الناس أو اختلفوا- لا تقبل الإثبات والنفي معاً، بل لا بدّ من نفي أو إثبات.
ومن هنا يمكن القول بطمأنينةٍ: إن الحق واحد لا يتعدد، والدين الحق لا يتعدد، وينبغي أن نبتعد بأذهاننا عن الحساسية المفرطة عندما نقول بوحدة الدين الحق، لأنّ ذلك لا يعني حتى الآن أننا جزمنا بتعيين موقع ذلك الحقّ، فإنّ مرجع ذلك إلى الأدلة الصحيحة لا إلى مجرّد الأمزجة والأهواء والعادات والتقاليد، وبالمناسبة فإنّ “وحدة الدين الحقّ” مبدأ مقرر لدى كل من الإسلام واليهودية والنصرانية وغيرها من الأديان العالمية الكبرى، وهذا يقرب كثيراً من وجهات النظر ويجعل محل النزاع الفكري واضحاً على الأقل ومعيار الفصل فيه أقرب، وأجدى في البعد عن المشتتات الفكرية والنفسية.
موقف القرآن الكريم من “وحدة الدين الحقّ”
إنّ القرآن يقرّر بوضوح أنّ الدين الحقّ واحدٌ لا يتعدّد، وأنّ العقائد التي يتضمنها الدين الحقّ واحدة هي أيضاً لا تتعدد، وذلك في آيات كثيرة، مثل قوله تعالى: {شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا} [الشورى: 13]، {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ} [الحج: 78]، وأيُّ آية قد يفهم منها خلاف هذا المعنى فهي ترجع بالتفسير الصحيح إلى هذا الاعتقاد المقرر في دين الإسلام.
ومع أنّ القرآن بين أنّ الإسلام هو الدّين الحقّ، {وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ} [آل عمران: 85]، {إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ} [آل عمران: 19]، إلا أنه لم يحابِ المسلمين، بل جعلهم سواسية مع غيرهم في وجوب بناء العقائد على أدلة صحيحة معتبرة، بل دعا المسلمين وغيرهم من أهل الأديان إلى “كلمة سواء” تقوم على مشتركات عقلية يمكن التسليم بها بقليل من التأمل وكثير من الإنصاف، قال الله تعالى: {قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ} [آل عمران: 64].
والله أعلم وأحكم.