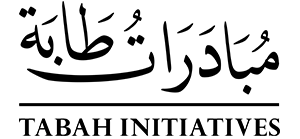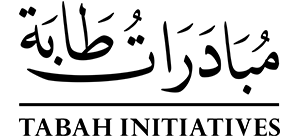كنت متجهًا نحو محطة قطار مدينة أوكسفود قبل أسبوع عندما مررت بأحد المستشرقين المخضرمين، فظللت أفكر كيف أن المرء في هذه المدينة المرتكزة حول جامعتها عرضة لأن يلتقي بالكثير من الكتاب والمفكرين بمجرد إقامته بها، وأنهم يرتادون نفس المكتبات والأسواق والمقاهي التي يرتادها.
ثم خطر في بالي أني ربما ألتقي بريتشارد دوكنز مرة أثناء التجول في المدينة بما أنه من ساكنيها، وظللت أسرح بخيالي في الطرق المختلفة التي قد يتأتى لي إفحامه بها، وكسره نفسيًا، وأن هذا لو تأتى لي يكون انتصارًا كبيرًا.. لكنه انتصار كبير لمن؟
هذه هي المرة الأولى في حياتي التي فكرت فيها أن ريتشارد دوكنز من أمة الدعوة، وأن هدايته ينبغي أن تكون غرض الداعي إلى الله الأساسي وليس إفحامه!
نعم، يجب علينا الرد عليه وأن نوضح بطلان دعاويه بقدر الإمكان، لكن بأي نية؟
هل الأليق بي كمسلم داعي إلى الله متبع لهدي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم أن أحب هدايته أكثر أم أن أحب أن أفحمه وأنكل به أكثر؟
وقتها تنبهت لقدر حظ نفسي في ما أحاول القيام به من خدمة دين الله، وتذكرت أن النفع بكلام الداعي إلى الله يكون بقدر إخلاصه، فكل كلام يبرز وعليه كسوة القلب الذي منه برز كما يقول سيدي أحمد بن عطاء الله السكندي، والقلوب تخاطب القلوب كما يقول المشايخ.
فكلما كان خطاب الداعي مع المدعو مشحونًا بحظ النفس الطالبة للانتصار الشخصي، كان تلقي المدعو بنفسه الآبية للإذعان للحق، وكلما كان الخطاب خارجًا من قلب يريد الله ورسوله، ويرى أن (الخلق عيال الله) وأن (أحبهم إلى الله أنفعهم لعياله)، اتسع قلب المخاطَب للإنصات والتفكر.
قال صلى الله عليه وآله وسلم: (لأن يهدي الله بك رجلًا خير لك من حمر النعم).
فكما كانت هداية الكفار الحربيين أحب إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قتلهم، ينبغي أن تكون هداية المحاربين الفكريين للدين اليوم أحب إلينا من إفحامهم وإظهار عوارهم.
_____________
مقال لمحمد سامي