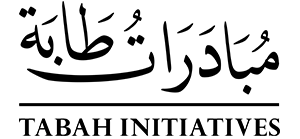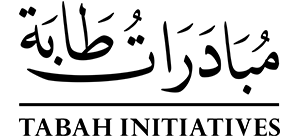أ. سامي الأزهري
معيد بكلية اللغة العربية بالأزهر الشريف
ينبني هذا السؤال على فَرَضيَّة غير مُسلَّمة، فإنَّ السائل يظن أن إعجاز القرآن محصور في نظمه وبلاغته، ولهذا استفهَم كيف يصل لهذا الإعجاز وهو ضعيف في العربية؟ ولكن هل ينحصر فعلًا إعجاز القرآن في بيانه وأسلوبه ؟!
قبل أن نخوض في هذا يَحسن أولًا أن نقول: إنَّ معنى الإعجاز أن يُقْدِر اللهُ بعضَ خَلقه من الأنبياء على أن يأتي بشيء خارج عن مقدورات الخلق، بشرط أن يكون هذا الأمر الخارق لمقدوراتهم موافقًا لدعواه مقصودًا به التحدي، وهذا الأمر يتوقَّف عليه صِدقُ الرسول، بحيث لو لم يأتِ به أو جاء مخالفًا لدعواه فهو كاذب.
والأبلغ في معجزة الرسول أن تكون من جنس ما برع فيه قومه؛ ليكون إقدارُه على الإتيان بشيء خارق لاستطاعتهم -وهو من جنس ما يعقلون ويفهمون-دليلًا على صدقه فيما يَدَّعيه، وبرهانًا على قطع الظن فيما يمكن أن يَظنُّوه، إذ عجزهم عن إيجاد مثل هذا الشيء الذي يفهمونه ويدركون معانيه تمام الإدراك أبلغ من عجزهم عن شيء لا يفهمونه ولا يدركون وجهه.
ولقد كان أهل الجزيرة العربية قُبَيلَ الإسلام ذوي فصاحة وبلاغة وعنايةٍ بأسباب البيان وأفانين القول، وحسبُك بقومٍ بلَغ من احتفالِهم بقدر الكلمة أن جَعلوا لها سُوقًا تماثل أسواق السِّلَع والمأكولات والمشروبات، بل بالغوا في ذلك حتى جعلوا للكلمة خصمًا وحَكمًا، فقَعَد النابغة الذبياني وضُرِبت له قُبَّة حمراء في ” عُكاظ ” يعرض فيها عليه المتسابقون ما نَظَموا وما قالوا، والمرء إذا احترف صناعة وبالَغ فيها تطلَّعَت نفسُه إلى بلوغ الصورة المثالية النهائية منها، ولا يكاد يصل إليها؛ لأنه كلَّما حصَّل منها جزءًا سبَقه خيالُ نفسه إلى مثالٍ أعزَّ وأعلى، فلمَّا نزَل القرآن الكريم على سيدنا رسول الله – صلى الله عليه وسلم – عَلِمُوا أن هذا هو الصورة الحقيقية للنموذج البياني الكامل الذي حَلَم به كل بليغ وتمنَّاه كل فصيح فلم يدركه أيٌّ منهم، فسارعوا إلى القول بأنه ليس من كلام البشر؛ لأنهم كثُر منهم الاعتناء بأجودِ ما قاله الناس فلم يجدوه مماثلًا له، فمنهم من صدَّق وآمن بأنه من الله، ومنهم من جَحد وأنكَر ونَسب الرسول – صلى الله عليه وسلم – إلى السحر والكهانة، وكلا الفريقين مُذعِن بنسبة هذا الكلام إلى شيء قوي قادر مفارقٍ لطاقة البشر، ثم لم يكتفوا بذلك، بل عاندوه وحاربوه، وإنَّ لُجوءَهم إلى الحرب وحملِ السلاح وبذل المال وفقدِ النفس والولد لَهُوَ أصدق دليل على عجزهم وقهرِ نفوسهم؛ إذ لو لم يعجزوا عنه فَلِمَ يحاربونه؟! ولماذا يتكبَّدون كل هذه الخسائر وهم قادرون على أن يأتوا بمثله ؟!
ولعلك تعترف معي بأن أهل كل صناعة هم أعلم بالجَيِّد منها وبالرديء وبالذي يتعذَّر على المثال، ولو أنك ألقيتَ في يد طفل رضيع قطعة من حَجر وخاتمًا من ذهب لمَا ميَّز بينهما، وأنت نفسك تنظر إلى عِيارات الذهب فتراها شيئًا واحدًا لا يتميَّز، في حين أن الصائغ يعرف صالحها من فاسدها بالنظرة الأولى وباللمسة الواحدة، ثم تجد تاجر العُملة يلمس الورقة النقدية فيعرف بمجرد اللمس ما إذا كانت مزوَّرة أو غير مزوّرة، دون أن يرفعها بيديه ويُبصِر علامات الصحة كما نفعل نحن، وكل هذا يكشف عنه هذا الخبر: فقد روى أهل اللغة والشعر أن رجلًا قال لخَلَفٍ الأحمر -وهو معروف بعلمه بالشعر وكلام العرب- : ما أُبَالي إذا سمعتُ شعرًا استحسنتُه ما قلتَ أنت وأصحابُك فيه !
فقال له: إذا أخذتَ درهمًا تَستحسِنُه، وقال لك الصَّيرفي: إنه رديءٌ هل ينفعُك استحسانُك إياه؟!.
نعم. لقد كان الكلام صناعة لها أهلها ومحترفوها الذين سَهُل عليهم معرفة مراتبه ودرجاته، والذين علِموا على وجه اليقين أن القرآن يستحيل أن يؤلفه بشر، ومن هنا كان القرآن معجزًا لهذه الفئة من الناس على مستوى البلاغة والبيان في المقام الأول.
ولمَّا كان القرآن العظيم بيانَ الله الأخير إلى الخلق أجمعين، عربيِّهم وعجميِّهم – وَجَب أن يكون إعجازه غيرَ محصور في البلاغة؛ إذ هو من هذا الوجه لم يصل إلى إدراك إعجازه إلا هذه الطبقة المخصوصة من العرب، وثمَّة فرق كبير بين فهمِ القرآن الكريم وإدراكِ أوامره ونواهيه وأخباره وبين فهمِ أنه مُعجِز، وبين الأمرين مفاوِز عظيمة يَضِلُّ فيها كثير من الناس، فباستطاعة الكثيرين أن يفهموا القرآن على الوجه الإجمالي، وأن يعرفوا ما الأمر فيه وما النهي وما الزَّجر وما النداء وما الدعاء، ولكن ليس بإمكان أي أحد أن يعرف وجهَ أنَّ هذا الكلام مُعجز إلا أن يكون من صَيارِفة الكلام الذين تحدَّثنا عنهم والذين قَضَوا حياتهم في معرفة الفروق بين مستويات كلام بعضهم بعضًا أوّلًا .
ومن رحمةِ الله بعقول الخلق أنْ ضَمَّن القرآنَ معجزاتٍ أخرى غير معجزة البيان؛ ليجيب عن سؤال العَجم ومن جرى مَجراهم: وماذا عنَّا ولسنا عرَبًا؟!.
فيقال لهم أوَّلًا: قد بَلَغكم أنه أعجَزَ العربَ الفصحاء، وأنه نادَى عليهم بعدمِ استطاعتهم أن يأتوا بمثله، وقد شَهِد التاريخ بصحة ما أخبَر، وإذا ثبَت أنهم عجزوا أمامه مع تمام الاستعداد وتوفر الداعي فغيرُهم عنه أعجز من باب الأولى، وبهذا الوجهِ يعلم غيرُ العربي الفصيح أن القرآن مُعجِز في بيانه وأسلوبه، ولكنه لا يدرك حقيقة هذا الإعجاز اللهم إلا أن يتأهَّل له بتهيُّؤٍ خاص وأدوات وشروط خاصة.
ثم يقال لهم ثانيًا: في القرآن كثير من وجوه الإعجاز غير الفصاحة والبلاغة، يمكن أن يقف عليها العربي والأعجمي، لعل أبرزها: الإعجاز التشريعي، والإعجاز الغَيبي.
ونعني بالإعجاز التشريعي : انتظام أوامر القرآن ونواهيه وتعليماته على نحوٍ شامل راقٍ يَضمن للناسِ العدل والرحمة ولا يؤدي إلى التناقض، فكيف لهذا الرجل الأمي -صلى الله عليه وسلم – وهو يعيش في بيئة بدوية بين أهله وعشيرته البدويين أن يأتي بمنهج متكامل يُنظِّم كل شئون حياتهم الدينية بأدق تفاصيلها أوَّلًا وشئون حياتهم الاجتماعية ثانيًا، ولم يضطرب ولم يتناقض تناقضًا حقيقيًّا في مسألة واحدة منذ أكثر من أربعة عشر قرنًا، وصاحبه لا يقرأ ولا يكتب، ولم يَنل حظًّا من التعليم، ولم يسافر ولم يطلع على مَاجَريَاتِ الأمم، فمن الذي عَلّمه كل هذا ؟!. ثم هو شجاع جريء لا يهاب أحدًا، ينادي بأعلى صوته ويتحدَّى ويقول :”ولو كان من عند غير الله لوجَدُوا فيه اختلافا كثيرا” فهل زعموا عليه اختلافا؟! وهل وجدوا فيه اضطرابا ؟!. في حين أن القوانين الوضعية التي يضعها البشر لا تخلو من شيء من هذا مهما تكرَّرت مراجعاتها، ومهما تَواتَر عليها المُحرِّرون والمُصحِّحون.
ونعني بالإعجاز الغَيبي: إنباء القرآن وكذلك إنباء الرسول – صلى الله عليه وسلم – بأمور غيبية يَقطَع بأنها وقَعَت أو ستقع حتما مؤكدا لا يقبل الظن والتخمين كما يفعل الكَهنة والمنَجِّمون، فحين يُخبر القرآن الكريم عن قصة إبليس، وقصة آدم، وبقية الأنبياء، وقصص الأمم السابقة، يُبلِّغها عن الله رجل أمِّي – صلى الله عليه وسلم – وحولَه من اليهود والنصارى مَن يعرفون هذه القصص من كتبهم ولم يزعموا أنه كاذب فيما أخبر، ولم يدَّعوا أنه تعلَّمها منهم أو أخذَها من كتبهم – فالعقل يقول: إن هناك سرًّا عظيمًا وراء هذا الرجل ينبئه بكل هذا، ويقول له “تلك من أنباء الغيب نُوحيها إليك، ما كنتَ تعلَمُها أنتَ ولا قومُك من قبلِ هذا “.
وحين يُخبره القرآن ويقول له: “غُلِبَتِ الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غَلَبهم سيَغلِبون” ويقول له: “لتدخلُنَّ المسجد الحرام” ويؤكد الجملة باللام ونون التوكيد، ويقول له: “قل لئن اجتمَعتِ الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا” – يجب أن نسأل: ما وراء تلك الثقة وذاك اليقين الذي يخالط هذا النص الكريم؟!!، وما تلك الأريحية التي ينطق بها هذا الرجل العظيم – صلى الله عليه وسلم -.
إنه لسان حال الواثق الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى.
وجملة القول أنا لا نَحصُر إعجاز القرآن في الوجه البلاغي؛ إذ هذا يجري في حقِّ طبقة خاصة من العرب، من أراد أن يفهم كيف أعجزهم القرآن وجَب عليه أن يصبر على سُبل التعلم ومصاعب التأمُّل والتروِّي والتدبر، لأن المَيزَ بين كلامٍ وكلام صناعةٌ كسائر الصناعات، والبالغ أعظمَ المراتب فيها غايتُه أن يكون في مستوى مَن أعجَزَهم هذا الوحي الكريم، على أنَّ في القرآن ضُروبًا أخرى من الإعجاز تضمَن لغير العربي البليغ – إذا كان منصفًا متجرّدًا للحقيقة- أن يعلم بأن هذا الكتاب ليس من تأليف النبي – صلى الله عليه وسلم – ولا غيره من الخلق.