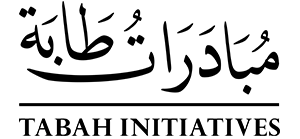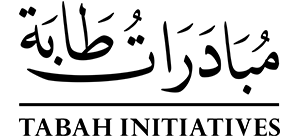د.عزة رمضان العابدة
مدرس العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر
بالأمس كنا نتحدث أنا وابنتي حديثًا طويلًا، اختتمته بقولها: “أنا نسيت كيف كنا نعيش قبل أزمة كورونا”، تركتْ ابنتي هذه الجملة خلفها وذهبت، لتنهال على رأسي عشرات الأسئلة حول الحياة قبل هذه الجائحة، كيف كانت؟ تذكرت خططنا التي كنا قد وضعناها في بداية العام لقضاء شهر رمضان الكريم، وإجازة عيد الفطر المبارك، ثم الاحتفال بنتائج الدراسة بعد إعلان نجاحهم، وبعدها قضاء إجازة الصيف.. أين ذهبت كل هذه الخطط؟ ولماذا تلاشت تلك الأحلام في لحظة؟
تلك اللحظة التي كانت فارقة في تاريخ البشرية هذا العام، الذي انقضى نصفه الأول بين مشاعر مختلطة وأخبار متضاربة وآراء متناقضة، وإجراءات واحترازات وإرشادات ودراسات حول هذا الفيروس الذي أصاب عددًا ليس بالقليل من سكان هذا الكوكب، الكل تأثر سواء من قريب أو من بعيد، الجميع شعر بالخوف ولو للحظات، الملايين استشعروا الخطر عندما بات المرض قريبًا منهم، أو أصبحوا هم على مقربة منه.
عدت بتفكيري إلى الوراء تخيلت لو أننا كنا نعيش تلك الحياة البدائية التي كان يحياها أجدادنا قبل آلاف السنين، في عصور لم يكن لديهم ما نحن فيه من تقدم علمي وتقني، لم يكن يخطر ببالهم تلك الرفاهية التي نتقلب فيها اليوم، تُرى كيف كانت نظرتهم لأنفسهم وللحياة، للصحة والمرض، للماضي والمستقبل؟ وكيف كان تعاملهم مع الطبيعة من حولهم؟ ماذا كان يعني لديهم ما نطلق عليه نحن اليوم “مجتمع المخاطر”؟
ما نوعية تلك الأزمات التي كانت تؤرقهم وتغير نمط حياتهم؟ وكيف كانوا يواجهونها آنذاك في ظل ضعف الإمكانيات التي كانت متاحة لهم؟ ماذا لو كانت ألمت بهم هذه الجائحة؟ هل كان لديهم خططًا تشبه خططنا المستقبلية؟ هل كنا نراهم منشغلين بكل هذه التفاصيل الكثيرة التي تشغلنا اليوم؟
ليست هذه دعوة للعودة إلى الماضي، أو للتقليل من أهمية العلم والتقدم، وإنما هي فقط وقفة للتأمل والتفكير في حجم التغيرات التي حدثت حولنا وداخلنا، كيف انعكس انشغالنا بكل هذه الأمور على حياتنا ونظرتنا لأنفسنا؟ وكيف أثّر هذا على تعاملنا مع الطبيعة من حولنا؟ كيف نَمَت لدينا كل هذه الرغبة في السيطرة والهيمنة على هذا الكون الذي نحن جزء منه؟
إذا كانت جائحة كورونا قد شكّلت أزمة واضحة امتدت تأثيراتها إلى شتى مجالات الحياة، على مستوى الفرد والمجتمع، محليًا وعالميًا، فإن هذه الأزمة في حدّ ذاتها، وبالنظر أيضًا إلى توابعها وتبعاتها، تمثّل جزءًا أو على الأقل مؤشرًا لأزمة كبرى ذات مخاطر متعددة، يواجهها الإنسان الحديث منذ بداية قيام الثورة العلمية في القرن السابع عشر، والتي كانت وظيفتها كما أعلنها أحد أعمدتها فرانسيس بيكون: “ضرورة السيطرة على الطبيعة وإجبارها على البوح بأسرارها، لا من أجل مجد الرب، بل من أجل التحكم في العالم والثروة”، في الوقت ذاته ظهر العديد من الأنساق الفلسفية الحديثة التي قامت على اختزال الحقيقة والوجود كله، بمراتبه ومقاماته وأحواله، حتى انتهى مع الديكارتية مثلًا إلى المادة والعقل فقط، متمثلًا في الذاتية الأنطولوجية والأبستمولوجية (الوجودية والمعرفية).
هذه النظرة الاختزالية سرت أيضًا إلى الطبيعة، فصيّرتها مجرد كمٍ بحت، يتعامل الإنسان من خلاله مع ظواهرها بالأرقام الحسابية والتجارب المعملية.
بمرور الوقت انعكست هذه الرؤى والفلسفات على ذات الإنسان، الذي فقد معها جزءًا من بنيته الثلاثية “الروح والعقل والجسد”، فصار عقلًا مرتبطًا بجسد على نحوٍ غامض، يكاد يختفى أو ينتفى معه الجانب الروحي.
منذ ذلك الحين والانسان يواصل مسيرته نحو انتهاك قداسة الكون بخطى متسارعة، حتى وصل به الحال إلى ادّعاء المطلقية، فجعل حقوقه واحتياجاته حاكمةً على الكون كله، الأمر الذي شغل بال الكثيرين من الفلاسفة والمفكرين، إيمانًا منهم بفداحة الأزمة ومخاطرها الحالية والمستقبلية، والتي ألقت بظلالها على العالم بأسره، “فالشرق والغرب يعانيان – كلٌ بطريقته – من أزمة واحدة مشتركة سببها الحالة الروحية للعالم الحديث، التي اتسمت بفقدان اليقين الديني، وفقدان الإيمان بالسمو والتعالى على الوجود المادي… لقد فقد العالم بُعده الانساني، وبدأنا نفقد السيطرة عليه” كما أعلن هوستن سميث في كتابه “لماذا الدين ضرورة حتمية؟”، إلا أن هذه الأزمة الروحية لم تقتصر تبعاتها على النوع الإنساني فقط، بل تعدّته إلى البيئة من حوله، الأمر الذي يشير إليه، السيد حسين نصر في كتابه “الإنسان والطبيعة” قائلًا: “من الغريب أن تكمن الإنسانية في قلب العقلانية العلمية اللاإنسانية، التي تنكر النظر إلى الأسباب الحقيقية التي أدت إلى أزمة البيئة الراهنة، وقطع السبل التي يجد فيها الإنسان الغربي منبع روحانيته، التي سوف تعين على إنقاذه من جائحة الأزمة”.
والحق أنه ما من شئ أخطر في الحوار الدائر اليوم حول البيئة من المنظور العلمي الذي يقطع الإنسان عن جذوره الروحية، فيرى الطبيعة بلا قداسة بعد أن كانت مقدسة عبر السنين، ويرى نفسه بعد تتويجه سيدًا عليها، عبارة عن مجموعة من الأعضاء يمكن استبدالها بقطع غيار، يربطها فيما بينها عقلٌ يمكن برمجته وتحسين قدراته.
إذا كان العالم مشغولًا في هذه اللحظة بما بعد الكورونا، فإن العالم الحديث وما بعد الحديث كان ولا زال منشغلًا بقضية أعم تتجاوز اللحظة الراهنة، بل إنها قد تتجاوز الإنسان الحالى نفسه، فيما يعرف ب”مابعد الإنسان” أو الإنسان المجاوز، بعد إجراء العديد من التحسينات البيولوجية والذهنية عليه، في ظل تنامي الطموح البشري في عصر المابعديات، وكيف أن أفكار الإنسان وتطلعاته قد تجاوزت هذا الكوكب الذي يعيش عليه منذ ملايين السنين، وكيف أغرى التقدم التقني والتكنولوجي هذا الكائن البشري ونفث في روعه، لتتبدل لديه الكثير من التصورات عن نفسه وعن الحياة من حوله. هذا “التقدم” يفرض علينا تساؤلات عدة من جهات مختلفة، من جهة علاقة الإنسان بنفسه وجسده وعلاقته بالبيئة من حوله، ومن جهة المخاطر التي قد تهدد الوجود البيولوجي للجنس البشري، وليس أدلّ على ذلك مما نواجهه الآن من أزمة كورونا التي ربما تكون نذير حربٍ بيولوجية عالمية، لن تقتصر أضرارها على الإنسانية فحسب، أو قد تكون بمثابة سلسلة من التجارب يحرّكها التوظيف السلبي للتقدم العلمي، سواء في تخليق الفيروسات ذاتها، أو في المتاجرة باللقاح الواقي منها، أو باحتكار الدواء واستغلال حاجة الناس إليه.
كذلك من جهة ما تستتبعه مثل هذه التدخلات والتحولات العلمية من انقلابات قِيمية وأخلاقية وقانونية وتشريعية، في ظل محاولة إحداث حالة من التماهي بين الظاهرة الإنسانية والظاهرة الطبيعية.
لقد كشفت الحداثة وما بعدها عن وجهها القبيح الذي يعبّر عنه ماركو بولو بقوله: “جحيم الأحياء ليس شيئًا سيكون، وإذا كان من جحيم فهو الجحيم الواقع هنا، الجحيم الذي نعيشه كل يوم، الجحيم الذي نشكّله معًا”، ولا يجد مناصًا من هذا الجحيم الذي صنعه الإنسان لنفسه بنفسه، إلا بأحد طريقين: الأول أن يقبل الإنسان بهذا الجحيم، ويتحول إلى جزء منه بحيث لا يمكنه رؤيته، وأما الثاني فمحفوف بالمخاطر ويتطلب يقظة وحذرًا دائمين، ولا سبيل لتفادي هذه المخاطر إلا بالعلم والمعرفة وبعودة الإنسان إلى إنسانيته، في كافة جوانبها وأبعادها المادية والعقلية والوجدانية والأخلاقية.
إن ماهية الإنسان من المنظور الديني أعمق وأوسع بكثير من التعريف الذي وضعه المناطقة والفلاسفة، لأنها تشتمل على الجوانب الثلاثة “البدن والعقل والروح” وحاصل مجموع هذه الثلاثية هو الذي يقود الإنسان للسؤال والبحث في الموضوعات النهائية والأسئلة الوجودية، كالسؤال عن ماهية الوجود وحقيقته، وعن المبادئ والعلل والغايات؛ ليعرف الإنسان من أين جاء وإلى أين سيصير، وماذا ينبغي عليه أن يكون.
إن إنسانيتنا تزدهر كلما انشغلنا بمثل هذه الأسئلة نتأملها ونفكر فيها، محلّقين بأرواحنا بعيدًا عن دائرة المادة وآثارها ومن هنا تبدأ خصوصية العقل المسلم واختلافه الجوهري عن العقل المشترك بين البشر، ليس الأمر ترتيبًا في درجات العقل، بل هو اختلاف نوعي في تصور الكون والحياة والوجود.
ما صنعته أزمة كورونا أنها أخرجت البشر من روتين حياتهم الذي اعتادوه بأدق تفاصيله، لتأخذهم إلى داخل ذواتهم، وإلى ذويهم، ومن ثم أتاحت لهم نظرة أقرب وأعمق في مختلف جوانب الحياة، وهذا يتوافق بشكل كبير مع ما هو معهود في أوقات الأزمات العامة، من أن الناس يتجهون نحو الحق الأساس، كما يقول المفكر الفرنسي بول بورجيه: “إن الإنسان يكون أشد تغلغلًا في الحقيقة، واستِكنَاهًا لها حين يكون أكثر تدينًا”.
إنها عادة الإنسان إذا اجتمعت عليه المخاوف والشدائد، فإنه يلجأ الى ربه، ظاهرًا وباطنًا، وينقطع رجاؤه عن كل ما سواه، هذا لا يعني مطلقًا أن الأخذ بأسباب العلم المادي في ذاته موضع نقض أو هجوم أو تقليل، وإنما الذي يستوجب النقد هو ادعائهم الاكتفاء به، وبقدرته على حل المشكلات الميتافيزيقية. والواقع أنه ليس كافيًا ولن يكون، إذ ليس بالعلم وحده يحيا الإنسان، ولا بالمادة فقط يتحقق الوجود الإنساني.
إننا اليوم نفتقر الى هذه النظرة التكاملية سواء في الطرح أو في المعالجة، لذا نجد أنفسنا أمام مشكلة أساسية، أو إن شئت قلت تأسيسية، تتجلى في أحادية نظرة الإنسان الحديث إلى الوجود، وفي محاولة تفسير ظواهره، ومن ثم في تعامله مع الطبيعة من حوله، ليس من منطلق شعوره بالمسئولية وتحملها، أو في إطار الغاية من خلقه والعمل على تحققها، وإنما من شدة حرصه على تحقيق منافعه المادية، وتحصيل شهواته البدنية، وإشباع رغباته الحسية، دون النظر إلى باقي الأبعاد العقلية والروحية والوجدانية، التي بها يكون الإنسان إنسانًا.
بالأمس كنا نتحدث أنا وابنتي حديثًا طويلًا، اختتمته بقولها: “أنا نسيت كيف كنا نعيش قبل أزمة كورونا”، تركتْ ابنتي هذه الجملة خلفها وذهبت، لتنهال على رأسي عشرات الأسئلة حول الحياة قبل هذه الجائحة، كيف كانت؟ تذكرت خططنا التي كنا قد وضعناها في بداية العام لقضاء شهر رمضان الكريم، وإجازة عيد الفطر المبارك، ثم الاحتفال بنتائج الدراسة بعد إعلان نجاحهم، وبعدها قضاء إجازة الصيف.. أين ذهبت كل هذه الخطط؟ ولماذا تلاشت تلك الأحلام في لحظة؟
تلك اللحظة التي كانت فارقة في تاريخ البشرية هذا العام، الذي انقضى نصفه الأول بين مشاعر مختلطة وأخبار متضاربة وآراء متناقضة، وإجراءات واحترازات وإرشادات ودراسات حول هذا الفيروس الذي أصاب عددًا ليس بالقليل من سكان هذا الكوكب، الكل تأثر سواء من قريب أو من بعيد، الجميع شعر بالخوف ولو للحظات، الملايين استشعروا الخطر عندما بات المرض قريبًا منهم، أو أصبحوا هم على مقربة منه.
عدت بتفكيري إلى الوراء تخيلت لو أننا كنا نعيش تلك الحياة البدائية التي كان يحياها أجدادنا قبل آلاف السنين، في عصور لم يكن لديهم ما نحن فيه من تقدم علمي وتقني، لم يكن يخطر ببالهم تلك الرفاهية التي نتقلب فيها اليوم، تُرى كيف كانت نظرتهم لأنفسهم وللحياة، للصحة والمرض، للماضي والمستقبل؟ وكيف كان تعاملهم مع الطبيعة من حولهم؟ ماذا كان يعني لديهم ما نطلق عليه نحن اليوم “مجتمع المخاطر”؟
ما نوعية تلك الأزمات التي كانت تؤرقهم وتغير نمط حياتهم؟ وكيف كانوا يواجهونها آنذاك في ظل ضعف الإمكانيات التي كانت متاحة لهم؟ ماذا لو كانت ألمت بهم هذه الجائحة؟ هل كان لديهم خططًا تشبه خططنا المستقبلية؟ هل كنا نراهم منشغلين بكل هذه التفاصيل الكثيرة التي تشغلنا اليوم؟
ليست هذه دعوة للعودة إلى الماضي، أو للتقليل من أهمية العلم والتقدم، وإنما هي فقط وقفة للتأمل والتفكير في حجم التغيرات التي حدثت حولنا وداخلنا، كيف انعكس انشغالنا بكل هذه الأمور على حياتنا ونظرتنا لأنفسنا؟ وكيف أثّر هذا على تعاملنا مع الطبيعة من حولنا؟ كيف نَمَت لدينا كل هذه الرغبة في السيطرة والهيمنة على هذا الكون الذي نحن جزء منه؟
إذا كانت جائحة كورونا قد شكّلت أزمة واضحة امتدت تأثيراتها إلى شتى مجالات الحياة، على مستوى الفرد والمجتمع، محليًا وعالميًا، فإن هذه الأزمة في حدّ ذاتها، وبالنظر أيضًا إلى توابعها وتبعاتها، تمثّل جزءًا أو على الأقل مؤشرًا لأزمة كبرى ذات مخاطر متعددة، يواجهها الإنسان الحديث منذ بداية قيام الثورة العلمية في القرن السابع عشر، والتي كانت وظيفتها كما أعلنها أحد أعمدتها فرانسيس بيكون: “ضرورة السيطرة على الطبيعة وإجبارها على البوح بأسرارها، لا من أجل مجد الرب، بل من أجل التحكم في العالم والثروة”، في الوقت ذاته ظهر العديد من الأنساق الفلسفية الحديثة التي قامت على اختزال الحقيقة والوجود كله، بمراتبه ومقاماته وأحواله، حتى انتهى مع الديكارتية مثلًا إلى المادة والعقل فقط، متمثلًا في الذاتية الأنطولوجية والأبستمولوجية (الوجودية والمعرفية).
هذه النظرة الاختزالية سرت أيضًا إلى الطبيعة، فصيّرتها مجرد كمٍ بحت، يتعامل الإنسان من خلاله مع ظواهرها بالأرقام الحسابية والتجارب المعملية.
بمرور الوقت انعكست هذه الرؤى والفلسفات على ذات الإنسان، الذي فقد معها جزءًا من بنيته الثلاثية “الروح والعقل والجسد”، فصار عقلًا مرتبطًا بجسد على نحوٍ غامض، يكاد يختفى أو ينتفى معه الجانب الروحي.
منذ ذلك الحين والانسان يواصل مسيرته نحو انتهاك قداسة الكون بخطى متسارعة، حتى وصل به الحال إلى ادّعاء المطلقية، فجعل حقوقه واحتياجاته حاكمةً على الكون كله، الأمر الذي شغل بال الكثيرين من الفلاسفة والمفكرين، إيمانًا منهم بفداحة الأزمة ومخاطرها الحالية والمستقبلية، والتي ألقت بظلالها على العالم بأسره، “فالشرق والغرب يعانيان – كلٌ بطريقته – من أزمة واحدة مشتركة سببها الحالة الروحية للعالم الحديث، التي اتسمت بفقدان اليقين الديني، وفقدان الإيمان بالسمو والتعالى على الوجود المادي… لقد فقد العالم بُعده الانساني، وبدأنا نفقد السيطرة عليه” كما أعلن هوستن سميث في كتابه “لماذا الدين ضرورة حتمية؟”، إلا أن هذه الأزمة الروحية لم تقتصر تبعاتها على النوع الإنساني فقط، بل تعدّته إلى البيئة من حوله، الأمر الذي يشير إليه، السيد حسين نصر في كتابه “الإنسان والطبيعة” قائلًا: “من الغريب أن تكمن الإنسانية في قلب العقلانية العلمية اللاإنسانية، التي تنكر النظر إلى الأسباب الحقيقية التي أدت إلى أزمة البيئة الراهنة، وقطع السبل التي يجد فيها الإنسان الغربي منبع روحانيته، التي سوف تعين على إنقاذه من جائحة الأزمة”.
والحق أنه ما من شئ أخطر في الحوار الدائر اليوم حول البيئة من المنظور العلمي الذي يقطع الإنسان عن جذوره الروحية، فيرى الطبيعة بلا قداسة بعد أن كانت مقدسة عبر السنين، ويرى نفسه بعد تتويجه سيدًا عليها، عبارة عن مجموعة من الأعضاء يمكن استبدالها بقطع غيار، يربطها فيما بينها عقلٌ يمكن برمجته وتحسين قدراته.
إذا كان العالم مشغولًا في هذه اللحظة بما بعد الكورونا، فإن العالم الحديث وما بعد الحديث كان ولا زال منشغلًا بقضية أعم تتجاوز اللحظة الراهنة، بل إنها قد تتجاوز الإنسان الحالى نفسه، فيما يعرف ب”مابعد الإنسان” أو الإنسان المجاوز، بعد إجراء العديد من التحسينات البيولوجية والذهنية عليه، في ظل تنامي الطموح البشري في عصر المابعديات، وكيف أن أفكار الإنسان وتطلعاته قد تجاوزت هذا الكوكب الذي يعيش عليه منذ ملايين السنين، وكيف أغرى التقدم التقني والتكنولوجي هذا الكائن البشري ونفث في روعه، لتتبدل لديه الكثير من التصورات عن نفسه وعن الحياة من حوله. هذا “التقدم” يفرض علينا تساؤلات عدة من جهات مختلفة، من جهة علاقة الإنسان بنفسه وجسده وعلاقته بالبيئة من حوله، ومن جهة المخاطر التي قد تهدد الوجود البيولوجي للجنس البشري، وليس أدلّ على ذلك مما نواجهه الآن من أزمة كورونا التي ربما تكون نذير حربٍ بيولوجية عالمية، لن تقتصر أضرارها على الإنسانية فحسب، أو قد تكون بمثابة سلسلة من التجارب يحرّكها التوظيف السلبي للتقدم العلمي، سواء في تخليق الفيروسات ذاتها، أو في المتاجرة باللقاح الواقي منها، أو باحتكار الدواء واستغلال حاجة الناس إليه.
كذلك من جهة ما تستتبعه مثل هذه التدخلات والتحولات العلمية من انقلابات قِيمية وأخلاقية وقانونية وتشريعية، في ظل محاولة إحداث حالة من التماهي بين الظاهرة الإنسانية والظاهرة الطبيعية.
لقد كشفت الحداثة وما بعدها عن وجهها القبيح الذي يعبّر عنه ماركو بولو بقوله: “جحيم الأحياء ليس شيئًا سيكون، وإذا كان من جحيم فهو الجحيم الواقع هنا، الجحيم الذي نعيشه كل يوم، الجحيم الذي نشكّله معًا”، ولا يجد مناصًا من هذا الجحيم الذي صنعه الإنسان لنفسه بنفسه، إلا بأحد طريقين: الأول أن يقبل الإنسان بهذا الجحيم، ويتحول إلى جزء منه بحيث لا يمكنه رؤيته، وأما الثاني فمحفوف بالمخاطر ويتطلب يقظة وحذرًا دائمين، ولا سبيل لتفادي هذه المخاطر إلا بالعلم والمعرفة وبعودة الإنسان إلى إنسانيته، في كافة جوانبها وأبعادها المادية والعقلية والوجدانية والأخلاقية.
إن ماهية الإنسان من المنظور الديني أعمق وأوسع بكثير من التعريف الذي وضعه المناطقة والفلاسفة، لأنها تشتمل على الجوانب الثلاثة “البدن والعقل والروح” وحاصل مجموع هذه الثلاثية هو الذي يقود الإنسان للسؤال والبحث في الموضوعات النهائية والأسئلة الوجودية، كالسؤال عن ماهية الوجود وحقيقته، وعن المبادئ والعلل والغايات؛ ليعرف الإنسان من أين جاء وإلى أين سيصير، وماذا ينبغي عليه أن يكون.
إن إنسانيتنا تزدهر كلما انشغلنا بمثل هذه الأسئلة نتأملها ونفكر فيها، محلّقين بأرواحنا بعيدًا عن دائرة المادة وآثارها ومن هنا تبدأ خصوصية العقل المسلم واختلافه الجوهري عن العقل المشترك بين البشر، ليس الأمر ترتيبًا في درجات العقل، بل هو اختلاف نوعي في تصور الكون والحياة والوجود.
ما صنعته أزمة كورونا أنها أخرجت البشر من روتين حياتهم الذي اعتادوه بأدق تفاصيله، لتأخذهم إلى داخل ذواتهم، وإلى ذويهم، ومن ثم أتاحت لهم نظرة أقرب وأعمق في مختلف جوانب الحياة، وهذا يتوافق بشكل كبير مع ما هو معهود في أوقات الأزمات العامة، من أن الناس يتجهون نحو الحق الأساس، كما يقول المفكر الفرنسي بول بورجيه: “إن الإنسان يكون أشد تغلغلًا في الحقيقة، واستِكنَاهًا لها حين يكون أكثر تدينًا”.
إنها عادة الإنسان إذا اجتمعت عليه المخاوف والشدائد، فإنه يلجأ الى ربه، ظاهرًا وباطنًا، وينقطع رجاؤه عن كل ما سواه، هذا لا يعني مطلقًا أن الأخذ بأسباب العلم المادي في ذاته موضع نقض أو هجوم أو تقليل، وإنما الذي يستوجب النقد هو ادعائهم الاكتفاء به، وبقدرته على حل المشكلات الميتافيزيقية. والواقع أنه ليس كافيًا ولن يكون، إذ ليس بالعلم وحده يحيا الإنسان، ولا بالمادة فقط يتحقق الوجود الإنساني.
إننا اليوم نفتقر الى هذه النظرة التكاملية سواء في الطرح أو في المعالجة، لذا نجد أنفسنا أمام مشكلة أساسية، أو إن شئت قلت تأسيسية، تتجلى في أحادية نظرة الإنسان الحديث إلى الوجود، وفي محاولة تفسير ظواهره، ومن ثم في تعامله مع الطبيعة من حوله، ليس من منطلق شعوره بالمسئولية وتحملها، أو في إطار الغاية من خلقه والعمل على تحققها، وإنما من شدة حرصه على تحقيق منافعه المادية، وتحصيل شهواته البدنية، وإشباع رغباته الحسية، دون النظر إلى باقي الأبعاد العقلية والروحية والوجدانية، التي بها يكون الإنسان إنسانًا.