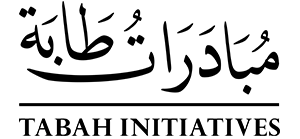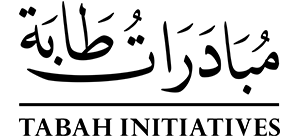كتبه: بيتر أدامسون
ترجمة: محمّد سامر الست
ماذا يمكن أن يجدَ أصحابُ الفلسفة الإنسانية وسواهم من غير المؤمنين في الفلسفة الإسلامية ما يثير اهتمامهم؟ إنّ العبارة توحي بإشكالية. وإذا كان تراث فلسفي يتميّز بأنّه إسلامي، فيبدو أنه لن يرى فيه أصحابُ الفلسفة الإنسانية إلا هدفًا للنقد؛ ولربما يذهبون أبعد من ذلك بزعمهم أنّ “الفلسفة الإسلامية” عبارة تجتمع فيها لفظتان متناقضتان. فالفلسفة عمل العقل غير المقيّد في البحث عن الفهم على أساسٍ من قوة الإدراك والنظر، لا على أساس الوحي أو الدين.
ومع أنّ هذا النهجَ في التفكير معقول ظاهريًّا، إلا أنني أريد أن أقنعكم بأنّه غير صحيح. ولنبدأ بالافتراض الأكبر وهو أنّ التفكّر الفلسفي يجب أن يستثني أيَّ سياق ديني. وهذا من الواضح أنّه لا يستند إلى حجّة قوية. فقد عَدَّ تقريبًا جميعُ فلاسفة العصور الوسطى المسيحيين أنفسَهم لاهوتيين. ويبدو جليًّا أنّ أيَّ تعريف لكلمة “فيلسوف” تستبعد بيير أبيلار أو توما الأكويني أو دَنز سكوتَس هو تعريف في أمسّ الحاجة إلى مراجعة وإعادة نظر. وقبل ذلك العصر بكثير، كانت أعمال كثيرين من المفكّرين القدامى ضمن إطار ديني ظاهر؛ وهذا جليٌّ على وجه الخصوص في العصور القديمة المتأخرة مع مسيحيين مثل أوغستين وبوثيوس، ولكنّه على الأقل ينطبق بالقدر ذاته على مفكّرين وثنيين مثل باميليخوس وبرُقلُس. فماذا عن أفلاطون؟ نحن لا نعدُّه مفكّرًا “دينيًّا”، ولكن مما لا ريب فيه أنّه نسج أفكارًا دينية في أعماله الفلسفية. ولتكتفوا بالنظر في محاورته “فيدروس” لترَوا ما أعني.
ومع ذلك يبدو أنَّ ثمة شيئًا ما يتعلّق بالفكرة القائلة إنّ الفلسفة ينبغي أن تنأى بنفسها عن المسلّمات الدينية. فما الذي يمكن أن يكون أبعد عن الفلسفة من قبول اعتقاد معيَّن بأنّه صحيح، فقط لأنّ الإنجيل أو أيّ نصّ من كتاب مقدّس آخر يؤيّده؟ ورجاؤنا أنّ أفلاطون لم يفعل ذلك. وهل فعل ذلك توما الأكويني؟ حسنٌ، نعم ولا. فهو مثل كثيرين من المفكّرين المسيحيين في العصور الوسطى تبنّى وجهة نظر معقّدة مطوّرة للعلاقة بين العقل والإيمان. فإنّ “النور الفطري للعقل” كافٍ لتأسيس إدراك فلسفي من المنطق إلى الفلسفة الطبيعية إلى دراسة الروح والأخلاق والسياسة. فبوسع العقل أن يصل إلى أبعد مدى حتى إلى الله، مثبتًا وجودَه وكثيرًا من صفاته. صحيحٌ أنَّ ثمة حقائق أخرى بعيدةٌ عن متناول العقل، مثل كون الله ثالوثًا، ولكنَّ هذه الحقائق حين يقبلها الإيمان يمكنها أن تُفهَم فهمًا أكمل باستخدام العقل. ومعظم المفكّرين في العالَم المسيحي في العصور الوسطى كان بوسعهم الالتقاء بأصحاب الفلسفة الإنسانية في منتصف الطريق بتقديم حجج عقلانية دون الرجوع أو الاحتكام إلى الإنجيل.
وماذا بخصوص الفلسفة الإسلامية، أو كما أُفضّل أن أقول: “الفلسفة في العالَم الإسلامي”؟ فقد يقودنا الصعود الحديث للأصولية الإسلامية إلى الظنّ بأنّ المفكّرين المسلمين على مدى التاريخ كانوا مقيَّدين بإملاءات من دينهم حتى أكثر من مسيحيي العصور الوسطى كتوما الأكويني؛ وهذا غير صحيح. ففي المسيحيّة اللاتينية قلّما كان الاشتغال بالفلسفة بغير سياق أو جدول عمل لاهوتي صريح، كما في نظريات المنطق واللغة التي تطوّرت في الجامعات في القرنين 13 و14، على سبيل المثال. أمّا في العالَم الإسلامي، فكانت هذه المزاولة المستقلّة للفلسفة أقرب إلى القاعدة منها إلى الاستثناء.
ففي مرحلة تكوين الفلسفة في العالم الإسلامي، أي حتى القرن 12 تقريبًا، كانت “الفلسفة” مرتبطة بالثقافة اليونانية ارتباطًا قويًّا؛ حتى أنّ أصل تسميتها “فلسفة” من الكلمة اليونانية philosophia. فكان “الفلاسفة” يطلبون عِلمًا من أصول أجنبية، لا سيّما أنّه مرتكز على دراسة أرسطو، ولكنه يستمدّ من عدّة مصادر أخرى في الرياضيات (إقليدس مثلًا)، والطب (جالينوس مثلًا)، والعلوم الطبيعية (بطليموس مثلًا)، والفلسفة (أفلوطين مثلًا). ولهذا السبب عُدَّت الفلسفة خارج العلوم الإسلامية ولا تقوم على أساس النص المقدّس. وبطبيعة الحال أدّت مخاوف إسلامية دورًا نوعًا ما في كتابات الفلاسفة، فلربما استشهدوا بالقرآن ليبيّنوا أنّ نظريّاتهم متوافقة مع الكتاب المقدّس. وفي بعض الأحيان يشكّك أحدهم بأنّ النظريات نفسها قد صُمِّمت لتناسب المعتقدات الإسلامية، مثل وحدانية الله وخلود الروح حين يبرهن عليهما بحجج عقلانية. ومن جهة أخرى، كانت وحدانية الله وخلود الروح موضوعَين عاديَين في الفلسفة الإغريقية اليونانية (أفلوطين كان يصرّ على كليهما)، وهو أمرٌ كان تغاضِي قرّاء الترجمات العربية عنه نادرًا. فحتى هذه المعتقدات كانت لا تتميّز باعتبارها إسلامية. وقد بذل الفلاسفة كثيرًا من جهودهم مشتغلين بعلم المنطق ونظرية المعرفة والفلسفة الطبيعية وغير ذلك من العلوم. وكانوا يتناولون المواضيع من دون استدعاء ديني ظاهر، وكانوا، بخلاف المسيحية اللاتينية، يعملون خارج أية مؤسسة دينية.
فكانت هذه الظروف والأحوال هي ما أمكن بعض المفكّرين في العالَم الإسلامي من تبنّي مذهبًا عقلانيًّا أكثر صرامة بكثير من أيِّ شيء يمكن أن نجده في أوربا المسيحية في ذات الحقبة الزمنية. فإننا نجد مثل هذا الموقف تحديدًا في الفارابي وابن رشد، اللذين عاشا في القرن العاشر في العراق والشام، وفي القرن الثاني عشر في الأندلس، على التوالي. فالفلسفة عندهما هي السعي لإثبات الحقائق بالبرهان، وهذا يعني تقديم أدلّة ثابتة تستند إلى مبادئ أولى مؤكّدة لا ريب فيها. وكان كلاهما يعدّ أرسطو عَلَمًا اقترب أكثر من أي مفكّر آخر من إتمام هذا المشروع الطموح؛ فعلى أعماله تعتمد نظرية الحقيقة البرهانية نفسها. وعند الفارابي وابن رشد للعِلم الأرسطي المنزلة المحتملة الأعلى، وجميع الأنواع الأخرى للمعرفة، بما فيها الدينية، غير كافية بالضرورة. وهذا لا يعني أنّ القرآن باطل، ولكنّه لا يعرض الحقائق إلا بطريقة غير علمية. إذ إنّ الخطاب الديني ذو إقناع وقوة وهو بالنسبة لعامّة المؤمنين صحيح، ولكنّه لا يبيّن التفسيرات العلمية للحقائق الكونية التي يدركها الفيلسوف البارع.
ومن ثمراتِ عالميةِ الفلسفة أنّ الحقائق والبراهين التي تكتشفها هي من حيث المبدأ مفتوحة لجميع الشعوب؛ وليس من حيث المبدأ فحسب. وقد استخدم أرسطو منطقه ليصل إلى حدٍّ أبعد من أي شخص آخر في اليونان. وفي العالم الإسلامي تطوّرت الفلسفة باعتبارها عملًا عالميًّا جامعًا يلتقي فيه المسلمون والمسيحيون واليهود على الأرضية المشتركية للفلسفة. وإنّ الترجمات اليونانية-العربية ذاتها التي أطلقت التراث الفلسفي بأنواعه قام بمعظمها علماء مسيحيون بطلب من رعاتهم المسلمين. ففي تلك الحقبة المبكّرة، على وجه الخصوص، كان يعني الاشتغالُ بالفلسفة التعاونَ مع مسيحيين في الغالب. وفي القرن التاسع قاد أول من سمّى نفسه فيلسوفًا في العالَم الإسلامي، الكندي، مجموعة من أولئك المترجمين المسيحيين. وبعد بضعة أجيال كان للفارابي معلّمون وتلاميذ مسيحيون، منهم يحيى بن عدي الذي شارك في مكاتبات فلسفية مع مُحاور يهودي. وقد شدَّد الفارابي وأقرانه على أنّ العلوم الفلسفية عابرة للثقافات في نواحٍ أخرى أيضًا. فالفلسفة لا يقيّدها أيُّ مكان أو شعب أو لغة. فمالوا إلى مقارنةِ شموليةِ صحةِ المنطق بمحدودية اهتماماتِ النحو والصرف الذي كان عِلمًا ناشئًا في أيامهم.
لذلك أُفضّل “الفلسفة في العالم الإسلامي” على “الفلسفة الإسلامية”: فكثير من المفكّرين المعنيين كانوا غير مسلمين، وحتى المسلمين منهم كانوا في الغالب مشتغلين بمجال بحث ونظر يميّزونه هم أنفسهم تمييزًا جليًّا عن العلوم “الإسلامية” التي منها علم تفسير القرآن. ومع ذلك ينبغي أن يكون المرء حذرًا فلا يبالغ، فلقد كانت الفلسفة عملًا عالميًّا جامعًا، ولكنّ أدواتها قد أمكن استخدامها أيضًا للنزاع والجدل بين الأديان. فقد كان الكندي سعيدًا بالتعاون مع مترجمين نصارى، بيد أنّه استخدم المنطق الأرسطي في مؤلّف صغير من أجل دحض عقيدة الثالوث المسيحية. وكون الفلسفة مجالًا دخيلًا هو نفسه ما جعلها هدفًا سهلًا. فكان بعضهم ينافح عن العلوم العربية أو الإسلامية الأصيلة، كالنحوي السيرافي الذي كان يسخر من المنطق اليوناني بوصفه ذا دعوى عريضة وغير مفيد في تحليل لغوي حقيقي للحجج والجمل. ثم جاء بعده نقاد ذهبوا أبعد من ذلك بإصدار أحكام فقهية تدين الاشتغال بالمنطق.
وثمة تحذير آخر مطلوب هنا: الفارابي وابن رشد من الشهرة بمكان، ولكنّهما لا يكادان يمثّلان الفلسفة في العالَم الإسلامي، فمذهبهما العقلاني الصارم وارتباطهما الكامل بأرسطو جعلهما محبوبَين أكثر عند مؤرّخي زماننا منهما عند القرّاء المعاصرين. وبترجمة مؤلّفات ابن رشد إلى العبرية واللاتينية صار له أثر أكبر بكثير على القرّاء اليهود والمسيحيين اللاتينيين منه على إخوته في الدين. وكانت المقاربة التوافقية هي الأكثر نمطية، إذ لا تدّعي ادّعاء مستفزًّا بأنّ البيان الفلسفي فوق الخطاب الديني؛ بل الذي كان مطروحًا هو أنّ البحث الفلسفي يصل إلى الاستنتاجات ذاتها المقرّرة في النصّ المقدّس، وهو تأكيد مستقل لحقائق الوحي.
حتى الآن كنت أتحدّث عن فلاسفة أعلنوا أنفسهم بأنّهم كذلك؛ ولكن بالعودة إلى الفلسفة في عالَم المسيحية اللاتينية في العصور الوسطى، فإن مفكّري تلك الثقافة الذين ننعتهم الآن بأنّهم “فلاسفة” لم يكونوا ليستخدموا هذا الوصف، فقد كانوا يرون أنفسهم لاهوتيين أو ربما شيئًا آخر. وكذلك في العالم الإسلامي كان يشتغل كثيرون بالفلسفة مع أنّهم يأبون أن يلقَّب أحدهم “فيلسوف”. ولعل الغزالي أفضل مثال لذلك، وهو المشهور بكتاب سمّاه “تهافت الفلاسفة”؛ وفيه سعى لبيان أخطاء الفلسفة والمآخذ عليها، وبذلك كان يقصد فلسفة ابن سينا. ولو سئل معظم العلماء عن الصفة الفكرية للغزالي فلربما قالوا إنّه كان “متكلّمًا”. ومع أنّه كان بارعًا في مجالات عديدة، ولكنه في هذا الشأن لم يكن كذلك. فكثير من المفكّرين الذين خاضوا في علم الكلام خاضوا في الجدل الفلسفي، فجادلوا هنا وهناك في مواضيع مثل حريّة الإرادة وطبيعة المعرفة.
وقد ساد تصوّر خاطئ أنّ الفلسفة في العالم الإسلامي شارفت على نهايتها في القرن 12، غير أنّ المتّفق عليه الآن بين أغلب أهل التخصّص في هذا المجال أنّ هذا ليس صحيحًا. والانطباع بأنّ الفلسفة ماتت في ذلك الوقت، حيث كان ابن رشد آخر ممثّل لها، يمكن أن يُعزى إلى عاملَين اثنين.
الأول، أنّ العلماء حتى وقت قريب كانوا مهتمين اهتمامًا منحصرًا تقريبًا في المؤلّفات الفلسفية العربية التي تُرجِمَت إلى اللاتينية، وذلك أنّهم أرادوا فهم الذين أثّروا بالمفكّرين المسيحيين كالأكويني. ومنذ أن بلغت حركة الترجمة اللاتينية-العربية أوجها في القرن 12، لم يؤثّر المفكّرون الذين جاؤوا بعد ذلك في أوربا تأثيرًا يُذكر.
الثاني، أنّه كان بالفعل يوجد تغيير في القرن 12، إلى حدِّ أنّ ابن سينا (المتوفى 1037) أخذ مكان أرسطو في ذلك الوقت باعتباره الشخصية الفلسفية المركزية. أمّا إذا ظنّ امرؤ أنّ “الفلسفة الإسلامية” هي تعامل مع مصادر إغريقية في الترجمة العربية، فقد يستنتج بسهولة أنّها انتهت في القرن 12. بيد أنّ هذا تعريف ضيّق نوعًا ما للفلسفة. فمنذ أجيال عديدة حتى الحقبة الاستعمارية تمامًا، كان يوجد تعاملٌ كثيف مع أفكار ابن سينا المثيرة والباهرة؛ فهو الذي نقّح فلسفة أرسطو ووضع بصمته الفارقة المميزة عليها. فكانت مؤلّفاته هي الموضوعَ لشروح ونقد وتلخيصات، مؤلّفات نالت حظّها من الشرح والنقد كما ينبغي. وتراوحت ردود الفعل بين اعتناق متحمّس لفلسفة ابن سينا ومعارضة مريرة لها. غير أنّ تأثيره كان عظيمًا، حتى أنّه كان أعظمَ من تأثير أرسطو في مرحلة التكوين، وذلك أنّ تأثير ابن سينا كان مستشعَرًا على نطاق أوسع. وصارت أساليبه ومصطلحاته نافذة إلى الخطاب الفكري، ووضعت جدول عمل المتكلّمين الفلاسفة من مصر إلى الهند المسلمة.
عُرف ابن سينا بأمور سيئة لعدة أسباب، منها أنّه كان يشرب الخمر ويقول بقدم العالَم؛ ولكنّ المفكّرين في العالَم الإسلامي رأَوا في كتاباته مصدرًا مكَّن من إعانتهم على مزاولة تأمّلاتهم المستقلة في أمور فلسفية وكلامية على حدٍّ سواء. وفي بعض الأحيان، حتى العناوين تخبر عن الحكاية، مثل كتاب “المعتبر” لأبي البركات البغدادي الذي كان يهوديًّا وأسلم، إذ “المعتبر” يعني “ما وضع موضع الاعتبار بعناية”. وكذلك كان مفكّرون آخرون، كالحاذق البارع كثير التأليف فخر الدين الرازي، يجدون متعة بالغة في قدرتهم على تقدير الحجج بالنظر إلى جميع جوانب المسألة قبل إصدار الحكم. وعمومًا صار علم الكلام بعد ذلك يشكّل انتقادًا قويًّا لكلِّ مَن يرى أنّ المفكرين الدينيين مقيّدون بالتراث. وكان لدى الناطقين بالعربية لفظة تصف الأخذ بالمرجع من غير تمحيص وهي: تقليد. وإذا كان ثمة موضوع حاضر في كلِّ تاريخ الفكرِ الإسلامي، فهو أهمية تجنّب هذه الخطيئة الفكرية.
ومنذ عهد مبكّر، نرى السنّة (ومنهم مفكّرون كثر مثل أبي بكر الرازي والغزالي) يتّهمون الشيعة بالتقليد، إذ إنّ الشيعة يتّبعون مرجعية إمام لا بد أن يكون من ذرية ابن عمّ النبي وزوج ابنته علي. ولكنَّ هذا القدح لم يكن يُرمى على الانقسام بين السنّة والشيعة فحسب. فقد كان الفلاسفة يتبرّمون من المتكلّمين لوقوعهم في ذنب التقليد، والمتكلّمون يردّون لهم الجميل بالتهمة نفسـها. ومع كلِّ ذلك، ألم يتّبع الفلاسفة أرسطو اتّباعًا أعمى؟ ولا يعني هذا أنّ المرء يجب أن يبدأ دائمًا من نقطة الصفر. في الشريعة الإسلامية كان أصحاب المذاهب الفقهية محترَمين معتبرين على الرغم من الفسحة التي تُركَت لاجتهاد الفقيه. وكذلك في الفلسفة وعلم الكلام، كانت آراء أرسطو أو الأشعري (صاحب المدرسة الأشعرية) محل إعجاب، بل محل تقدير واعتبار. وما كان لأرسطي أو أشعري ليقولَ إنّه يعتقد أمرًا لمجرد أنْ قال به سلف له وجيه محترم. إنّما كان النظر المستقل والمخلص يثبت أقوال المذهب، وغالبًا ما كان يفضي إلى مراجعات لتلك الأقوال أو إضافات عليها.
وقد استمر الموقف السلبي تجاه التقليد بعد المرحلة التكوينية بكثير، وقد صدر حديثًا كتاب لخالد الرويهب يناقش فيه المتكلّم المغربي، السنوسي، الذي عاش في القرن 15، والذي قال إنّ على جميع المسلمين واجب النظر، وعدم القيام بهذا الواجب هو تقليد، وهو عند السنوسي “أصل كفر عبدة الأوثان”. فقد ذهب فعلًا قلّةٌ من المفكّرين بعيدًا إلى هذا الحدّ. لكنَّ المعتمد أكثر هو القول إنّ التقليد ملائم لعامة الناس غير المتعلّمين الذين لا يسعهم تجاوز الرأي السائد، بل ينبغي لهم اتّباع أثر العلماء المتفننين أو تجنّب التنقيب في أمور فوق مستواهم؛ وهذه فكرة مشابهة كثيرًا جدًّا للفكرة التي طرحها الفارابي وابن رشد، ما عدا أنّها هنا لا تتعلّق بالفلاسفة إنّما بأهل الدراية في الشريعة وعلم الكلام الذين يكوِّنون أهل الفكر.
ورب قائل يقول إنّ رفض التقليد وما يستلزم من روح النظر العقلي كان الخيط المشترك الذي ربط جميع مفكّري العالَم الإسلامي الذين يميلون إلى الفلسفة بعضهم ببعض. فكان خيطًا امتدّ عبر الحدود التاريخية والدينية. فقد كان لدى يهوديٍّ عالمٍ بالشرائع والفلسفة مثل موسى بن ميمون من القواسم المشتركة مع معاصره وزميله الأندلسي ابن رشد، في بعض النواحي، أكثر مما لديه من القواسم المشتركة مع أيِّ شخص يهودي عادي. فبطبيعة الحال، لم يكن جميع المثقفين متفائلين كثيرًا بتطلّعات البحث والنظر المستقل. فقد سبق أن رأينا أنّه كان يوجد مشكّكون في المنطق، وكان كثير من الصوفية والمتكلّمين يؤكّدون أنّ العقل البشري له حدود. ثم كانت أيضًا توجد علاقات محكومة بنظام بين المعلّم والتلميذ عبر مراحل المجال الفكري، تتضمّن مدة تدريب في غضون تَشَكُّلِ عقل التلميذ. ولكن ما إن وصلنا إلى عصر الحداثة حتى ظهر علماء دين ناضجون يمثّلون الاتجاه السائد لم يُرَ منهم الاهتمام بالنظر في الحقائق. وبذلك كانوا يحذون حذو الفلاسفة الأوائل ومَن تأثّر بهم كالغزالي وفخر الدين الرازي. وهذا لا يعني الزعمَ بأنّ لهذه الشخصيات أدنى انتماء إلى الفلسفة الإنسانية، ولكن هذا يعني أنَّ الإيمان في العالم الإسلامي نادرًا ما كان أعمى.