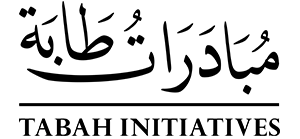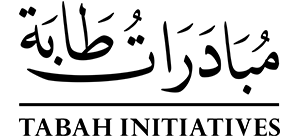كتبه معتصم إسماعيل
“أعطني دليلًا علميًا على ما تقول”. “أنا لا أؤمن إلا بالعلم”. “العلم محايد و لا علاقة له بالدين أو الأخلاق”. “لا تخلط العلم بالدين”. “لا تخلط العلم بالأخلاق”.
هذه عينة من مقولات شائعة ترسَّخت لدى كثيرين، خصوصًا مع تسارع الاكتشافات العلمية و التطوُّرات التقنية في العصر الحديث، و انبهار الكثيرين بقدرة (العلم) على حل المشكلات و تحسين حياة الإنسان. و لكن، ما هو هذا (العلم) الذي يشيع (الإيمان) به في العصر الحديث؟ و هل هو كافٍ ليغني الإنسان عن الدين و الأخلاق؟ و هل هو فعلًا محايد؟ هذه الأسئلة هي موضوع هذا المقال، و الذي يمهِّد لمقالات لاحقة تتناول المأزق الأخلاقي للإنسان الحديث و حاجته لتجديد صلته بعالم الغيب ليستعيد أخلاقيته (أو قل: إنسانيته).
تَرافَق مشروع التنوير و التحديث في أوروبا مع عملية (عقلنة Rationalization) لجميع جوانب الحياة، بإخضاعها لنظر العقل وفق قواعد (علمية) يغلب عليها النظرة التجريبية للعلم (Empiricism)، أي تلك النظرة التي تطلب دليلًا من الواقع الملموس و المرئي، و لا تعبأ بالتصورات و التفسيرات الغيبية، بل ولا حتى بالقيم الأخلاقية الخارجة عن الواقع المرئي، حتى شاعت مقولة أن العلوم يجب أن تكون محايدة قيميًا value-free، و أن اعتبار القيم يُفقد العلوم صفتها (العلمية).
لن أخوض في هذا المقال في نقاش فلسفي حول معنى (العلم) و (العقل) و (القيمة)، بل سأركِّز الحديث حول ما نتج من مآزق أخلاقية تعانيها الإنسانية اليوم بسبب تجاهل البعد الغيبي للوجود و حصر وعي الإنسان و فاعليته في الواقع المرئي فقط.
لا يُنكر عاقل أهمية ما وصلت إليه العلوم التجريبية الحديثة و ما أبدعته من تقنيات. ما أنكره في هذا المقال هو قدرة هذه العلوم على تزويد الإنسان بتصوُّرات نهائية عن وجوده و عالمه و غاياته و قِيَمه الأخلاقية، أي قدرتها على منح المعنى لوجود الإنسان و فاعليته. بل أقول إن انحصار وعي الإنسان فيما أنتجته الحضارة الحديثة من منتجات مادية و وسائل سيطرة و تحكّم بالمجتمعات و الطبيعة فتح الباب لكثير من العَنَت و الضيق و التخبُّط الواضح في مجتمعات اليوم.
تنبَّه كثير من المفكرين و الفلاسفة المعاصرين إلى المآزق الأخلاقية التي تعيشها المجتمعات اليوم بسبب غلبة (التصوُّر الأداتي) على الحضارة الحديثة، أي الانشغال بالأدوات و الوسائل و الغفلة عن المقاصد. من أشهرهم الفيلسوف الألماني (يورغان هابرماس) الذي نقد ما أسماه (العقلانية الأداتية) السائدة في خطاب الحداثة و التي تختزل الإنسان و فاعليته في ترتيبات لتحقيق غايات لا يعيها و لا يشارك في تحديدها. بل إن الانبهار بالتطوُّرات التقنية و تطبيقاتها و ما يصاحبها من تأثير إعلامي، أدّى إلى أن تصبح هذه الترتيبات (الأداتية) غايات بحد ذاتها، و هو ما يعبِّر عنه الفيلسوف المغربي طه عبدالرحمن بالنزعة الاختزالية السائدة في الحداثة والتي تحوِّل الوسائل إلى مقاصد.
أدّت نزعة الاختزال الكامنة في الممارسة (العلمية) و التقنية الحديثة إلى أشكال من الضيق في وجود الإنسان و وعيه، نتجت عن فهمه الضيِّق للواقع المحيط به. فالممارسة العلمية تعتمد على مقاربة الظواهر المحيطة بنا من خلال منهجيات و أدوات تسمح بالتعامل مع هذه الظواهر و إخضاعها للدراسة و التحليل. إلا أن هذه المنهجيات تتطلب اختزال الظواهر إلى بعض عناصرها لنتمكن من التعامل معها، و لا يمكن للإنسان أن يحيط بظاهرة ما إحاطةً كاملة من جميع جوانبها. فالطبيب مثلًا يلجأ إلى اختزال حالة المريض في مؤشرات محدودة كضغط الدم و درجة الحرارة و بعض الفحوصات المخبرية، رغم علمه بأن العوامل المؤثرة على حالة المريض و العناصر المكوِّنة لها أكثر و أعقد من أن تُختزَل في مؤشرات محدودة. و كذلك في الاقتصاد، تُستخدَم مؤشرات محدودة كالناتج المحلي الإجمالي و التضخم و نسبة البطالة و غيرها لفهم اقتصادات الدول، رغم أن الظواهر الاقتصادية أعقد بكثير من أن تُختزَل في هذه المؤشرات. إلى هنا، لا مشكلة، هذه طبيعة العلوم، لا يمكن لأي منهج علمي أن يحيط بالظاهرة المدروسة إحاطةً كاملة. لذا، تعتمد العلوم على تصوُّرات مختزَلة و مجتزأة للواقع، لا تعبِّر عنه بشكل كامل، لكنها مفيدة إجرائيًا في التعامل معه. تبدأ المشكلة عندما تتحوَّل التصوُّرات الإجرائية لظواهر الواقع إلى تصوُّرات نهائية تزعم الإحاطة بالواقع و القدرة على التحكم فيه، مع ترسيخ هذه التصوُّرات بإضفاء صفة (العلمية) و (العقلانية) عليها. فينحصر اهتمام الطبيب مثلًا في ضبط بعض المؤشرات المتعلقة بحالة المريض و يغفل عن الحالة نفسها كما يعيشها المريض، و ينحصر اهتمام الاقتصادي في ضبط المؤشرات الاقتصادية المتعارَف عليها و يغفل عن ما يعانيه الناس فعليًا في معاشهم. أي أن الظاهرة تُختزَل في أدوات و مؤشرات قياسها، و تتحوَّل هذه الأدوات و المؤشرات إلى غايات في ذاتها بعد أن كانت وسائل، و يغفل الإنسان عن أبعاد كثيرة في الظواهر المحيطة به بسبب عدم قدرته على قياسها، فيتجاهلها و كأنها غير موجودة.
و بالنظر في واقع المجتمعات الإنسانية اليوم، نجد أن الجوانب غير المرئية في الواقع (أو قل: الجوانب الغيبية) التي يتجاهلها الإنسان، لا تلبث أن تتحوّل مع الزمن إلى جوانب مرئية و ملموسة، حين تبدأ آثار تجاهلها بالظهور على شكل أزماتٍ يحار فيها الإنسان. فبعد أن ظنَّ أنه قادر على التحكم بواقعه، إذا به يفاجأ بتعقيدات لم يحسب لها حسابًا بسبب انحصار وعيه و فاعليته في فهم ضيِّق للواقع، و اعتماده على ترتيبات و وسائل مبنية على هذا الفهم الضيِّق و تجاهله لجوانب مهمة في واقعه لمجرد أنه لا يراها و لا يلمسها. و كأنَّ الغيب يرُدُّ على هذا التجاهل بأن يصفع الإنسان بالأزمات المتتالية، لعلَّه يفيق من غفلته و يتوب من غروره و يتواضع في تعامله مع الكون. فلنفكِّر في الأزمات المالية المتعاقبة، أو في مستويات التفاوت الاقتصادي الشديد بين الطبقات داخل الدول و بين الدول المختلفة، أو في التلوث البيئي، أو في الحروب المدمِّرة، أو في التطرف و الإرهاب، أو في استلاب الإنسان الحديث من قِبَل وسائل الإعلام و الترفيه، أو في النسب غير المسبوقة لتفكُّك الأسر، و غير ذلك الكثير من الأزمات التي تعصف بالبشرية اليوم رغم كل التطوُّر (العلمي) و التقني. ما لا يدركه المنبهرون بهذا التطوُّر هو أنه تطوُّر محدود، بل محدود جدًا. ذلك أن الواقع أوسع بكثير من أن يقدر هذا (التطوُّر) على قياسه و التعامل معه.
إذن، إجابتي على الأسئلة التي بدأتُ بها هذا المقال هي أن العلم الذي يشيع في زماننا (الإيمان) به هو العلم التجريبي و التطبيق التقني المعني بالظواهر المرئية الملموسة، و هو مفيد، بل و محمود، إن بقي في إطاره المحدود كوسيلة إجرائية لفهم الواقع و التعامل معه. و طبيعته المحدودة (من حيث موضوعاته و من حيث أدواته) تبيِّن بوضوح أنه لا يغني البشرية عن الدين و الأخلاق. كما أن ادِّعاء الحياد القيمي للعلم لا معنى له ما دمنا أقررنا بطبيعته الإجرائية، و الإجراءات لا بد لها من قِيَم توجِّهها. أما مزاعم الحياد القيمي للعلم فقد أدّت إلى تحوُّل السرديات (العلمية) و التطبيقات التقنية و أدواتها و وسائلها إلى مقاصد و غايات نهائية توجِّه الإنسان و تحدِّد له قِيَمه و تحصرها في واقعه المادي، مما قاده إلى العَنَت و الضيق، بل و إلى فقدان معنى إنسانيته.
خلاصة هذا المقال أن خروج الإنسان المعاصر من الأزمات و العَنَت الذي صار إليه يتطلب توسيع وعيه بالواقع من حوله و ترقية مقاصده و غاياته، و لا يتم هذا إلا باستعادة صلته بعالم الغيب. في المقال القادم، سأدلِّل على هذه الدعوى.