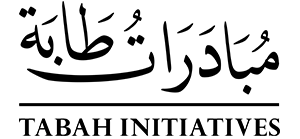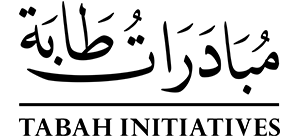الأحكام الأخلاقية الحديثة والأحكام الشرعية
عبد الرحمن الفرجاني
باحث دكتوراة في الفلسفة وعلم الكلام
إن المتتبع لمستجدات العصر – عصر ما بعد الحداثة – والأنظمة العالمية التي تسعى منذ انتهاء الحرب العالمية (الأوروبية) الثانية إلى بناء عالم جديد، يهيمن عليه قيم وأخلاق كلية مشتركة بين البشر، من التسامح، والتحاور، والمساواة، والحرية، والحقوق – حتى لا يتكرر ما حصل فيما سبق من الحروب التي لم يشهد له التاريخ سابق مثال. ورغم أن هذه الأنظمة – بعضها تابعة للحكومات وبعضها تابعة لمنظمات مستقلة – لم تنجح كل النجاح في إنهاء الحروب، نجحت إلى حدٍّ كبير في نشر العقائد الجديدة التي تقوّم الثقافة الحديثة.
ولا يخفى على المتتبع – لا سيّما الماركسي منهم – أن هذه القيم هي ناتجة عن ثقافة غربية متجذرة في الرأسمالية، إذ الليبرالية السائدة في هذا العصر هي عبارة عن إيديولوجية الرأسمالية، ومع ذلك، فإنهم يسوّقون لهذه القيم على أساس أنها كلية أو فطرية – صالحة لكل مكان زمان، وأن المعجزة الغربية هي في إنتاج ثقافة هي من جهة جزئية تاريخية، إلا أنها كلية عالمية في آن واحد. وفي الغالب، إن انتشار هذه الأفكار – انتشارها معلوم لكلّ من له أدنى شعور تاريخي – لم تكن بطريق المناظرة والحجة، وإنما من خلال إدماج الثقافات الضعيفة مادّيًا في النظام الجديد، فمع انتشار هذا النمط الجديد، والمؤسسات الجديدة، والقوانين الجديدة، حتى المأكل والملبس، أصبح المسلم خاصّة في موضع غريب، بل وجد نفسه سائحًا في وطنه، وشعر بالعزلة والإبعاد بين أبناء جلدته.
وجد أن ثقافته – بما في ذلك من تصوّرات وأحكام وميول وأذواق – ليست محل اشتراك بينه وبين أكثر شعبه، حى كاد لا يشترك في شيء مع والدَيه، فما بالك بالأجداد. وكذلك بين طبقات المجتمع – إذ كل ما زاد الشخص في الغنى، كل ما كان مرتبطا بالاقتصاد العالمي، فكل ما كان مرتبطا بالثقافة الجديدة. وفوق ذلك كلّه، وجد أن هناك فرق شاسع ومقلق بين ما وجد في نفسه من اعتقادات حول بعض الأحكام الأخلاقية وما يدعى بالأحكام الشرعية. أليس هناك مساواة بين الرجل والمرأة؟ فما بال أصحاب العمائم يفرّقون بينهما في الميراث والشهادات والمسؤليات والحقوق والملبس، كما يروّج في برامج التلفزيون والراديو وقنوات اليوتوب؟
فإنك ترى بعض الناس – حيث سنحت له الفرصة – يقول إن هذه الأحكام عقلية وكلية، ومن خالفها فهو على خطأ قطعًا، فإما أن نؤوّل هذه الأحكام الشرعية أو نتركها، ونجعل من التراث الإسلامي عبارة عن موروث ثقافي، يتعلق بالمواسم والمناسبات، والأخلاق العامة، لكن، لا مدخلية له في وصف الواقع، ولا تحديد الأحكام الشرعية. وقال بعضهم: بل المخالفات بين الأحكام المتفق عليه عالمياً – كالحرية الذاتية والمساواة – هما الأصلان اللذان عليهما محور منظومة أخلاق البشر، فمن خالفهما فهو ردّ، وبالتالي، إن هذا الدين لا يمكن أن يكون منزّل من عند الله، فإنه لا يمكن أن يصدر عن الإله ما يعرفه العقل باطلا بأدنى نظر!
ومع كون هذا القول الأخير أصرح في العبارة ومتسق أكثر من الأوّل، إلا أن مآلهما واحد، إزالة الإسلام من واقع المسلمين، وإبدالها بأمر آخر جديد، والفرق بينهما أن الأوّل يريد أن يتدرّج بالناس حتى لا يواجههم ردة فعل قوية وتفشل خطته، والثاني صاحب عزيمة وثقة ببرنامجه، لا سيّما والعالم خلفه، يصبّون ميئات الملايين في المنظمات التي تنشر هذه الأفكار، علاوة على أن الثقافة السائدة تنشر هذه العقائد عبر الأفلام والروايات وغير ذلك، فإنه يريد أن يشعل بين الناس هذه الفتنة، ويلفت أنظار الناس الى مستقبل جديد يسوقونه لهم، وذلك الحلم سهل التصوّر، إذ هو يبثّ لنا في كلّ يوم وليلة، ألا وهو النموذج الغربي للحياة.
ولكن، هل يسلّم لهم هذا كله؟ أليس يجب علي – قبل قبول هذه الاقتراحات الجديدة، التي سيترتب عليها تحوّلات عنيفة في مجتمعي – أن أنظر فيها بإمعان ونقد؟ إذ المعلوم أن الدول التي تصدّر لنا هذه الأفكار تحاربنا من جهات شتى؟ وإن سلمنا لهم، فمن سيربح من هذه التجارة؟ نحن أم هم؟ ولا أقول إن هذه مؤامرات سرّية، بل هي اقتراحات حقيقية مسطورة في مواضعها حتى يعترض معترض عليّ ويقول: هذا هروب من أصل المسألة، فإنه غير مهم ممن يصدر عنه هذه الاقتراحات، بل الأهم النظر في نفس مضمونها! وهذا وإن كان سائغًا في النقاشات النظرية البحتة مسلّمًا، لكنه غير سائغ في الأنظار الواقعية، فإن الذي يجري ههنا مبادرة الجواب عنها سيحدّد لي مصيري في حياتي الدنيوية – وربما الأخروية أيضًا إن وجد – فيجب عليّ أن أتأكّد: هل هذا البائع صادق أم لا؟ هل بضاعته أصلية أم لا؟
إن مثل هذه الإشكالات – التعارض المزعوم بين القيم العالمية وبين (القيم الإسلامية) مما سبّب أكثر بلبلة بين المسلمين في هذا العصر، والذي يراه الكاتب أن مبنى ذلك مغالطات كلها عائدة إلى فهم هذه القيم بأنها عقلية بحتة، غير مشوبة بحسّ أو ذوق أو ثقافة أو غير ذلك من الاحتمالات. ثم بعد أن يسلّم الناظر بأنها عقلية، يلتفت إلى الأحكام الشرعية ويحكم ببطلانها بناء على تعارضها بهذه الأحكام العقلية المزعومة. ولكن عندما ننظر في هذه الأحكام، لا نجد أنها صادرة عن العقل، بل، الأرجح أنها صادرة عن مجموعة من الأشياء، منها أنها هي المتفقة لأغراض من حكم بها، أو لثقافته، أو لأحواله وسياقه التاريخي وغير ذلك.
فإن علماء الإسلام قديمًا – خاصة المتلكمين وعلماء أصول الفقه – نظروا في الأحكام العملية والأخلاقية، ونظروا في أصولها: هل يحسن الفعل بذاته فيأمرنا به الربّ؟ أم هل إن أمر الربّ به فيحسن؟ فمن قال بالأوّل قال إن العقل يمكن – من حيث الإمكان الذاتي لا الوقوعي – أن يدرك حسن الأفعال وقبحها باستقلال، لأن وصفها بالحسن والقبح أمر ذاتي لها. ومن قال بالثاني، قل إنه غير ممكن، لأنه لا يوجد وصف لهذا الفعل أصلًا بناءً عليه نحكم بحسنه أو قبحه، وإنما ما يحكمون به الناس هو عائد إلى شعور نفساني أو إلى ثقافة ترب عليها أو غرض وافقه أم خالفه، وذلك كله لا يكفي في إيجاب الأفعال على الناس! وإن ما يدعون فيه عقلانية الأحكام هي عادئ الى الأوهام، ومن نظر في بعض الأمثلة على ذلك تجلّى له صدق هذا القول.
أذكر مرة في مؤتمر ما، ناقش أحد المشاركين رجلًا من الفقهاء، وقال له: إن في دينكم أحكام مثل الجلد، وهو فعل قبيح همجي وحشي! فإن سألنا أنفسنا، هل كلامه هذا صحيح ومبني على العقل؟ أم هو عبارة عن شعور نفسانية لم يرتق قائلها من حضيض الحسّ إلى إدراك العقل؟ كلامه من جهة الحسّ صحيح: إن الجلد ليس أمرًا ملائم لطبائع البشر، فليس هناك (إلا بعض المنحرفين) من يتلذذ بالجلد، ولكن، هذه عقوبة، فلا شكّ أن شأنها هذا النوع من القبح، وإلا فلن تفي بالمطلوب، أي عقوبة المجرم. ثم إذا سألنا أنفسنا: ألا يوجد عقوبة أخرى (“أكثر إنسانية”) من هذا؟ قد يقول قائل: نعم، السجن. لكن إذا خيّرنا القاضي بين خمس سنين في السجن أو عشرة، وبين خمسين جلدة أو ميئة، ماذا سيكون جوابكم؟ حاشانا من الوقوع في جريمة توجب ذلك، لكن يبدو لي أن الجواب واضح أيضًا، بل إن بعض من جرّب الحياة في السجن وما فيها من تعذيب للنفس الإنسانية وسلب حياتها عنها – إذ كما يقول القوم: حياتك أزمانك – أن الجلد أرحم بالإنسان من السجن، ومع ذلك فهو أوقع على قلبه من حيث التعليم، وأشد في تحذير الآخرين، وأحوط عن استغلال المستغلين الذين جعلوا من السجون مصانع للشركات، يجعلون المسجونين فيها يعملون لهم، ويربحون أرباحًا كبيرة من ورائهم. وهلّا توقف ذلك القائل قبل أن حكم على الشرع بالوحشيّة ورمى بنفسه إلى الهلاك؟
نعود ونقول: إن نفس الفعل – الظاهرة الخارجية الصادرة عن الإنسان كسبًا منه – لا تتصف بصفة ذاتية بها ندرك حسنها وقبحها، وإنما ما نسميه في عرفنا بالحسن والقبيح عائد إلى أغراضنا – أعمّ من أن يكون مؤلمًا أم لا. وهذه النقطة مهمّة جدّا: إذ بها نستطيع أن نحلّل كل دعوى أخلاقية خاصّة إذا ادّعى المدعي أنها عقلية بحتة، فنسأل نظرًا لأي غرض من الأغراض حسن هذا الفعل أم قبح؟ ومن يحدّد لنا هذه الأغراض؟ وفي صالح من؟ إن من تمعّن في القيم العالمية الآن، يعرف تمامًا أن هذه الأغراض يحددها نفس تلك الثقافة – بل النخبة منهم، رؤوس الأموال – وإدماج شعوب العالم في نظامهم يجعل على أعينهم ستارًا لامعًا مزينًا بحيث يتبنون هذه الأغراض ويشربون هذه القيم من حيث لا يشعرون. لكن، هل هذه الأغراض هي فعلًا في صالحنا أم هي في صالح غيري، وإنما أعطيت حظًا من الدنيا لأنسى حقي ولا أشتكي؟
وعلى كلّ، فإنه من المغالطة أن يأتي شخص بأحكام يتوهم أنها عقلية ثم يحكم على ما لدينا بالبطلان قبل أن مناقشة أصول هذه الأحكام ومنشأها. أما نحن فجوابنا – كما قرّره علمائنا قديمًا – أن الأحكام صادرة من الله تعالى وفقًا لإرادته، غير معلّلة بعلّة أصلًا، وإن كانت في نفس الوقت فيها صلاحنا الدنيوي والأخروي. بل، ولم يكلّفنا بإيجاب هذه الأحكام على غير المسلمين – بخلاف مدعين العقلانية في هذا العصر، إذ كونها واجبة وكلية، جددوا لأنفسهم حروبًا صليبية جديدة لنشر الدين الجديد – وتركنا كل ملة تفعل ما تشاء، ولم نعارضهم من جهة الفروع إلا بما ترتب عليه مفسدة دينية أو دنيوية وفقًا للقواعد الشرعية. وهنا ينجلي أمر آخر: فإن الحداثة تقول لنا: لا طريق إلى معرفة الحقائق الدينية من وجود الله وصفاته وصدق النبوّة، لكن، نعلم الأحكام الأخلاقية بعقولنا والأخلاق هي الحاكمة بين الناس، وذلك أهم الأشياء! وأما رواد الفكر الإسلامي قديما – وهم الأشاعرة بلا منازع – قالوا: بل، لا يدرك العقل أحكامًا كلية موجبة على كل الناس من حيث هم عقلاء فقط، بل ليس هناك شيء في الخارج قبل ورود الشرع يجعل فعلا من الأفعال قبيحا أو حسنا أصلا – وإنما هي نسب وإضافات واعتبارات تابعة للسياق والأغراض وهي أشبه بما قاله البلاغيين في وصف الكلام البليغ بأنه المطابق لمقتضى الحال! وذلك قطعًا لا يكون كليًا ولا واجبًا على أحد كما يظنون. بل عكسوا قولهم وقالوا: إن العقل يدرك حركة الأجسام وسكونها، واجتماعها وافتراقها، وتغيرّها، وذلك يدل على وجود فاعل لهذه الحوادث الممكنة قطعًا – حتى يتصولون الى إثبات وجود الصانع لهذا العالم الممكن، ثم بناء عليه وإثبات النبوّات بالعقل، نسلّم لأدوات الشرع في اسنتباط الأحكام. والله الموفق.