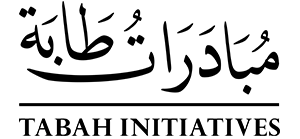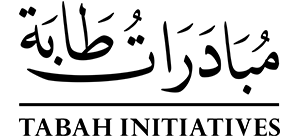مصطفى ثابت
باحث رئيس بمؤسسة طابة
شاهدتُ منذ أيام مقطعًا مُصوّرًا للفنان العالمي أنتوني هوبكنز في مُقابَلة مع قناة BBC، حول دوره الأخير في فِلم The Two Popes والذي جسّد فيه شخصية البابا بِندكت السادس عشر، كان هوبكنز في هذه المُقابلة يتحدث عن مُعتقدِه؛ حيثُ صرّح بأنّه شخص “لا أدري” Agnostic، وكان الذي جَذَبَ انتباهي في حديثه كلامه عن قيمة الشّكّ وخطورة اليقين، حتى بدا هوبكنز كأنه يُنشد قصيدةً بليغةً في مديح الشّكِّ والحيرة.
كان مما ذكره هوبكنز في هذه المقابلة قوله:
-إنّ أيَّ شخص ذكيّ يكون لديه شُكوك، ففي الشّكّ يوجد التواضع والتقوى، ثم يُواصل: -إذا كُنتَ تملك اليقين فأنتَ مَيِّت، اليقين يُدمّر الناس، لقد دمّرَ هِتْلر 40 مليون إنسان لأنه كان مُتيقّنًا، لأنه كان يعرف، لكن لا أحد يعرف. فأعظم طريقة للحياة أن تعيش الشّكّ باستمرار، وأعظم قيمة روحيّة على الإطلاق هي ألا تعلمَ شيئا.
يسألُه الـمُـحاورُ قائلا: -أليس من أساسيات الإيمان ألا يكون لديك أي شكوك؟
فيُجيب هوبكنز:- «هذا إذا كنتَ تتحدث عن محاكم التفتيش، لكن أي شخص مؤمن فلديه شكوك، كل ما أعرفه أن هناك لغزًا أكبر في حياتي ولا يمكنني أن أفهمه.
فأنا لا أعلم من أنا؟! ولا من أينَ أتيت؟! ولا إلى أين سأذهب؟! وليس لديّ أي فكرة حول مَنْ خَلَقَنِي؟ نَحنُ لسنا مُميزين في شَيء، في النِّهاية نحن مجرّد رماد». اهـ
كلام هوبكنز في الحقيقة لم يكن مُفاجِئًا بالنسبة لي، فنسبية العلوم والمعارف، والشكّ المستمرّ في كل شيء بما فيها المُسلّمات العقلية –سمةٌ مُميزة للعصر الذي نعيش فيه؛ عصرِ ما بعد الحداثة، لكن الذي يدعو للاستغراب هو احتفاء بعض الأصدقاء من العرب والمسلمين بحالة الشك تلك، والابتعاد المستمر عن اليقين؛ باعتبارها عنوان التواضع والتسامح المنشود، ولأن هذا هو “العُمق” اللائق بالفنان أو المفكر في هذا العصر، أن يبتعد كلما أمكنه عن “ادعاء الحقيقة” ويميل قدر الإمكان “للشك”، الشكّ فحسْب، فهنا أصبح الشّك قيمة في ذاته بِغضِّ النظر عن إمكان أو عدم إمكان وصولنا للحقيقة.
في البداية لَسْتُ أختلف مع هوبكنز ولا غيره في أن الشكّ أحيانا قد يكون مُفيدًا ونافِعًا لصاحبه، لكن نفعه باعتباره وسيلة للمعرفة وسببًا يدعو الإنسان إلى الاجتهاد في طلب الحق وإرادة الوصول إلى اليقين؛ لأن فطرة الإنسان لا تشعر بالراحة إلا مع اليقين، ولكن هناك فَرق بين اليقين القائم على الجهل المركّب الممزوج بالثقة العمياء في الأفكار بدون دليل، وبين اليقين القائم على الأدلة والبراهين، والشواهد القائمة على النّظر المنطِقيّ، والاسترشاد المتواصل بالعلم والمعرفة.
يقول حجّة الإسلام أبو حامد الغزاليّ ت 505 هـ رحمه الله: «الشكوك هي الموصّلة إلى الحق. فمن لم يشك لم ينظر، ومن لم ينظر لم يُبْصر، ومن لم يُبْصر، بقي في العمى والضلال. نعوذ بالله من ذلك»[1]. ويقول الفيلسوف الفرنسي رينيه ديكارت في رسالة بعثها إلى بويتندك عام 1643م: «الشك وسيلة للحصول على معرفة الحقيقة معرفة أكثر وضوحًا».
فالشكّ مُفيد من هذه الحيثية؛ أنه باعث على النظر والتفكير للوصول إلى الحقيقة المبنية على الدليل، وهذا الذي يُسمّى بالشّكّ المنهجي أو الشّك الفَلسَفِيّ، الشكِّ الذي يؤسِّس لرفض التقليد والاتباع الأعمى، ويدعو لاتباع الدليل، والبحث المتواصل من خلال وسائل المعرفة المتاحة عن بعض الحقائق والمعارف؛ أما أن يكون الشكُّ قيمة في ذاته، ويُمتدح لذاته باعتباره الحالة الفكريّة الأرقى و”العمق” المطلوب من المفكرين والفلاسفة، ووسيلة التسامح العُظمى فهو معاندة لفطرة الإنسان الباحثة عن الأمان المتواجد في عمق الحقيقة واليقين، وقتل لحجية العقل والبرهان، وهدم لكثير من وسائل المعرفة وليس عُمقًا أو تسامحًا إلا مع السفسطة والحيرة، وهو الشك المذهبي أو الشك الارتيابي الهدمي.
وفي سياق وجود بعض اليقينيات عند أهل الأديان، نرى أنه يتمّ لمزهم بسخرية ووصفهم بأنهم دوجمائيون، وأحب هنا أن أشير إلى أن مصطلح الدوجما Dogma معناه العقيدة، أو الاعتقاد أو اليقين بشيء ما، سواء كان هذا اليقين مُبرهنًا عليه أم لا، والدوجمائية Dogmatism هي مذهب فلسفي يعني الوثوقية أو القطعية أو التوكيدية، وهو مذهب الذين يؤمنون بقدرة العقل على الوصول إلى الحقيقة وإدراك اليقين وهي ضد الريبيّة أو الشكيّة Skepticism، التي لا تؤمن بإمكان الوصول أو الجزم بالحقيقة أو لا تُسلّم بوجود حقيقة أو ما يسمى بالواقع ونفس الأمر، ثم حدث تَغيّر دلالي ما على معنى الدوجمائية منذ أيام الفيسلوف الألماني إيمانويل كانط، وأصبح للوثوقية Dogmatism دلالة لا تخلو من التّهكّم والسخرية؛ وصارت تُطلق على التسليم بآراء معينة دون تمحيص أو استدلال، فهي بهذا المعنى مقابلة للنقديّة Criticism، وهو المذهب الذي أرساه كانط. ويدخل في مقابل الوثوقية أيضا كل مذهب يرى عجز العقل عن الوصول إلى الحقائق التي تُجاوز طوره في رأيهم، مثل وضعية أوجست كونت، وتطورية هربرت سبنسر، ونسبية هاملتون، ونقدية كانط.
وقد ذكرت الإشارة السابقة كي أقول إن الدلالة السّاخرة التي يطلقها اللاأدريون على المتدينين بأنهم دوجمائيون لا تلزم كثيرا من أهل الأديان كالمسلمين وقد تكون صادقة على أصحاب أيدولوجيات أو أفكار أخرى –دينية ولادينية- من الذين يتعصبون لآراء واعتقادات دون أن يكون هناك أي سبيل لإثبات صحتها أو خطئها؛ أما العقيدة الإسلامية فليس فيها تسليم بوجود حقائق أو يقينيات من غير دليل، وليس فيه اعتقاد فكرة أو عقيدة إلا بعد أن يقوم عليها البرهان العقلي القاطع، ولهذا وجدنا مُقدِّماتِ كتب التوحيد أو علم الكلام مليئة بذَمِّ المقلّد، وهو الشخص الذي عنده عقيدة من غير دليل، وهو ما قرره القرآن الكريم عندما ذمّ أقوامًا ليس لاعتقادهم أي مسوغ من عقل أو برهان إلا لكونه دين الآباء والأجداد، {وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ} [البقرة: 170].
ومن المفارقات أنه يُمكنني أن أدّعي أن قول الفنان العالمي أنتوني هوبكنز: «إن أعظم قيمة روحية للحياة هي أن تعيش الشَّك باستمرار» وقوله: «اليقين يدمر الناس»، وقوله: «نحن لسنا مميزين في شيء، بل نحن مجرد رماد» هو نوع من أنواع الدوجما، لأنها أفكار لم يُقدم لنا أي دليل عليها ومع ذلك فهو يجزم بها بكل ثقة، بل أقول هذا نوع من أنواع الإرهاب الفكري الذي يصف اللاأدريون به المؤمنين في هذا العصر، وهو أن اليقين يتنافى مع التسامح، وأن كل موقن بدينه أو بأفكاره الكلية عن الله والكون والإنسان فهو نازيّ ومشروع إرهابي بالضرورة؛ وأقول إنه إرهاب فكري لأن إلغاء الفروق الجوهرية بين العقائد والأديان والادعاء أنها كلها على مسافة واحدة من الحقيقة؛ لأننا لا نعرف الحقيقة، أو لأنه لا توجد حقيقة، هو في الحقيقة إكراه على التسامح وليس تسامحًا؛ إذ التَّسامح الحقيقي في وجهة نظري أن أعتقد أنني مختلف معك في آرائك ودينك وأعتقد جزما أنني على الحق، لكن لا يمنعني اختلافي معك ويقيني بكون الآخر على باطل -من احترام شخصه ومحبته ومودّته ورجاء الخير له، والتعايش معه في سلام، واستمرار وضع النقاش معه على مائدة البحث والتلاقي المعرفي، لكن إذا ألغينا الفروق بين المعتقدات والآراء الفلسفية والدينية وزعمنا أنها كلها تنصهر تحت لا أدرية مبهمة، وتتساوى في شكوكية غير جازمة، حتى يصير هناك اشتراك ومظلة جامعة لكل هذه الأفكار وبالتالي يصبح التسامح بينها منطقيًا، فهذا هو منتهى العجز عن تحقيق التسامح، ثم أين هي المحبة والتسامح المبنيين على السخرية ممن لا يعتقد إنكار الحقائق واستحالة الوصول إليها، وتسخيف رأيه واعتقاده؟!
كذلك من المهم جدا في هذا السِّياق أن يُفرّق الباحث بين مجالات العلوم والمعارف التي يمكن فيها أن تكون أحكامها قطعية وبين الحقول المعرفية الأخرى التي يكون مبنى الأحكام فيها قائمًا في الأغلب على الظنِّ والترجيح، لأنه لا تتوفر فيها المدخلات أو المقدمات التي تكفي للقطع، فلسْنَا ندّعي الحقيقة المطلقة في كل شيء من تصوراتنا وأحكامنا، فالعلوم الاجتماعية الحديثة أغلب أحكامها في دائرة الظَّنِ، كالسِّياسة وعلم النفس وعلم الاجتماع وغيرها، والميل إلى إصدار الأحكام القطعية في هذه الدوائر قد يكون فيه قفزات غير منطقية، ولا مانع أن تكون بعض أحكام هذه العلوم قطعية إلا أنها قليلة ونادرة، وأيضا في ميدان العلوم الإسلامية هناك علوم كاملة أكثر مسائلها قائمة على الظن الراجح كعلم الفقه، أما في الفلسفة والعقائد، فإن المتكلمين والفلاسفة دائما يُسبقون الكلام فيها بالكلام على نظرية المعرفة وإمكان الوصول لليقين في الإلهيات، وما هي مصادر المعرفة التي يُعتمد عليها في الوصول للحقائق، ومناقشة مستفيضة مع الآراء والأفكار والمذاهب التي تتبنى اللاأدرية والسفسطة والشكوكية، وتفرقة بين موارد القطع وموارد الظن، كل هذا قبل الدخول في مباحث الإلهيات والميتافيزيقا، حتى لا يدعي مدعٍ أن بحث المتدينين في هذه القضايا نوع من المصادرة أو الدوجما كما يُردد بعض مُثقفينا اليوم للأسف.
في النهاية أحب أن أقول للقارئ الكريم إنّ التاريخ يخبرنا دائما بأمرين: أولهما: أنه إذا سيطر الشك والنسبية على الأمم والجماعات والأفراد، بحيث لم يعد هناك أفكار كلية يقينية، وعقائد وقطعيات تشكل الخصوصية الإيمانية والثقافية لأُمةٍ ما، فإن الذي سيسود في العالم هو ثقافة الأقوى وأفكاره شئنا أم أبينا، فالضعيف والمغلوب دائما مولع بتقليد الغالب، مالم يكن لدى الأضعف حضاريًا خصوصية ثقافية وفكرية راسخة منطلقة من يقينه المبني على نظرته الكلية للعالم والإنسان، تمكنه من عدم الذوبان في ثقافة الأقوى.
وثانيهما: أنه متى استقرّ لدى الأمم والأفراد تَعذّرُ الوصول إلى الحقيقة بين الفرقاء على مائدة العقل والمنطق في صراع وجهات النظر، فلن يكون هناك معيار للصواب والخطأ إلا معيار السيف والبندقية والقنابل، فمتى غاب سلطان العقل والمنطق وحُجّيتهما ارتفع سلطان السلاح، وكما يقول أبو العلاء المعري وهو يلخص فلسفة إرادة القوة التي نادى بها فريدريك نيتشه في مقابل رفضه لمعقولية الحقيقة:
تَلَوْا باطِلاً، وجلَوْا صارِماً، وقالوا: صدَقنا! فقلتم: نعَم![2]
[1] ميزان العمل للغزالي ص 409 ت سليمان دنيا.
[2] معنى بيت المعري: أنهم قالوا كلامًا فارغًا ثم لوحوا بسيوفهم على سبيل التهديد وقالوا: كلامنا هو الصواب بعينه، فلم نستطع إلا أن نعترف بأنهم رائعون، وعلى حق.
قم بتقييم المحتوي